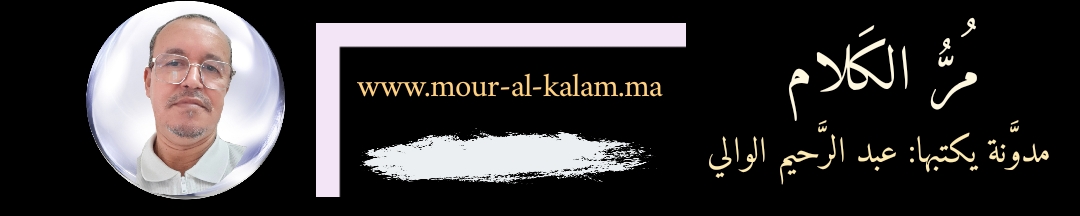قبل يوم 04 فبراير 1998، تاريخ تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول، كان في المغرب السياسي فريقان: يسارٌ لم يشارك في السلطة التنفيذية إلا في حالات نادرة كحالة عبد الرحيم بوعبيد، ويمينٌ يوصف بعضه ب”التقليدي” وبعضُه ب”الإداري”، وسبق له أن اغترف من ينابيع السلطة، أو حتى أنها كانت هي التي صنعته، واصْطَنَعَتْهُ لنفسها، في بعض الحالات.
كانت ثقافة الأول، في ما كان مُعْلَناً على الأقل، ثقافة “نضالية”. وحتى إذا كانت القيادات في أغلبها تستفيد تحت الطاولة من العديد من الامتيازات، فالغالب على القواعد الحزبية اليسارية كان نُكْرَانَ الذات. وكان المناضلون والمناضلات يؤدون ضريبة العمل النضالي من وقتهم، وأموالهم، وفي أحيان كثيرة من حريتهم أو حتى من حياتهم. ومهما كانت الخلافات عميقةً مع القيادات فقد كان المناضلون والمناضلات في القواعد الحزبية يُعَزُّونَ أنفُسَهم بأن الأحزاب كإطارات لم تكن مِلْكاً لتلك القيادات. ولم يكن من النادر أن تجد مناضلا أو مناضلة من القاعدة الحزبية ينتفض ضد عبد الرحيم بوعبيد، أو علي يعته، أو محمد بنسعيد أيت إيدر، رغم الكُلفة الباهظة لانتفاضات من هذا القبيل في أحزاب كانت تقوم على مبدأ “المركزية الديموقراطية” المستوحى من النظام السوفياتي بنفحاته الستالينية، والممزوج بنَفَسٍ ناصري بالنسبة للبعض، أو بنفسٍ بعثي صدَّامي بالنسبة للبعض الآخر.
لكنْ، في كل ذلك كانت ثقافة المكاتب الفاخرة، والأرائك الوتيرة، ثقافة غريبة عن اليسار ومُستَهْجَنَةً في صفوفه. أما في ما بعد 04 فبراير 1998، فقد انتقلت كل أمراض اليمين، تقليدياً كان أو إدارياً، إلى جسد اليسار. وظهرت فئة من “المناضلين” تصنف نفسَها في “القسم الوَثَني الأول”، الذي يعبُد الكراسي الكبرى، لتستحوذ على المقاعد الوزارية وتتهافت على مقاعد البرلمان بغرفتيه، وتركض وراء مقاعد الرئاسة في المقاطعات والبلديات والجماعات ومجالس الجهات.
ووراء هذه الفئة ظهر صنفٌ ثانٍ من الجراد يلهث وراء مقاعد الدواوين الوزارية. فقد كان لكل وزير الحق في تعيين مدير لديوانه إلى جانب مُستَشارَين اثنين. وموقعٌ من هذا القبيل معناه أنك تصير، من الناحية العملية، وسيطاً بين الوزير والمصالح المركزية والخارجية الخاضعة لوصايته أولاً، ووسيطاً ـ في الآن نفسه ـ بين أصحاب الحاجات والمصالح من جهة ومعالي الوزير من جهة أخرى. وبالطبع، لا نتحدث عن الوساطات الأخرى التي هي مَا يصنعُ في الغالب هذه الفئة من الوسطاء نفسَها.
هذه الفئة الثانية هي التي أسميها “كلاب الدواوين”، والتي لا تقتصر على الذين وصلوا إلى وضع مؤخراتهم فعلاً في دواوين الوزارات، وإنما هي تشمل كل الطامحين والطامحات إلى ذلك، أي إلى إيجاد منزلة ل”طَرَامِيحِهم” على الكراسي الديوانية. فلم يعد الالتحاقُ بأحزاب اليسار، كما كان في زمن الرصاص، يتم بأفق نضالي وإنما هو أضحى خاضعاً لمنطق الغنيمة. وعوض المناضل الصلب، الصنديد، المُخْشَوْشِنِ إيماناً بأن النِّعَم لا تدوم، والمستعد في كل وقت وحين لزيارات الفجر ول”مُعلَّقات” الليالي العشر في “الدار الحمراء” أو “درب مولاي الشريف” أو غيابات “الستيام”، صرنا أمام غلمان بصُدور ومؤخرات تكاد تنافس السيدة كيم كارداشيان على درب التصريح بالممتلكات. وبدل المناضلين الذين كانوا يتنافسون في تدقيق الموقف من قضية ما، ويقضون ساعات من النقاش حول جملة أو عبارة في بلاغ أو بيان، ألفينا أنفسنا أمام طوابير من “الفاصوليا الخضراء” التي تتسابق على أنواع العطور المستقدمة من بلاد السين، بل وتزاحم النساء في أحيان كثيرة على دهون الوجه والشفتين، ولديها الاستعداد الكامل للانحناء، وتولية مؤخراتها شَطْرَ الأسياد، “لكل غاية مفيدة”.
ماذا كانت نتيجة كل ذلك؟
طبعا، لقد تحقق ما كانت تتطلع إليه أوساط بعينها، كان هاجسُها الأول والأخير هو دَكُّ كل النتوءات النضالية في المشهد السياسي والنقابي وتسويتُها بأديم الانبطاح. وربما لم يكن صدفةً أن اللغة العربية القديمة كانت تسمي الأرض المستوية ب”القَحْبَاء”. فقد تمت التسوية كما يجب ونجحت “قَحْبَنَة” الجميع، أي أن الجميع صار منبطحاً والحمدُ لله الذي لا يُحمَد على مكروه سواه.