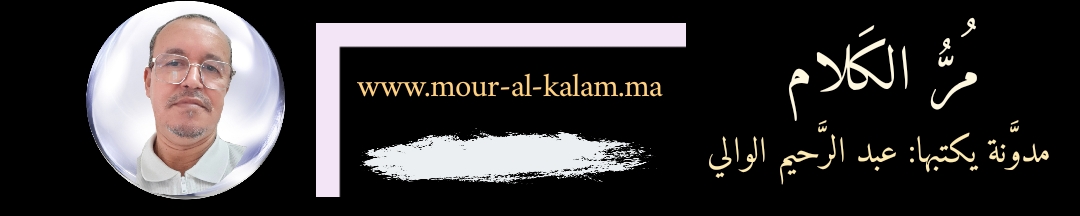كثيراً ما يُحْمَلُ على الفلسفة، والفن، والأدب، والنضال السياسي، دورٌ تحريري. وذلك معناه أن على هذه الأشكال من التفكير، والإبداع، والعمل، تحريرُ مَنْ يُصَنَّفُون عادةً ضمن “المُضطَهَدين” و”المقموعين” و”المُسْتَغَلِّين” وما إلى ذلك.
لكنَّ التاريخ والواقع معاً يقولان بأن هذا الرهان كان على الدوام رهاناً خاسراً وفاشلاً. وبقدر ما كان الفشل الذريع والخسران المبين ملازمين لكل محاولات ما سُمِّيَ ب”التحرر” و”الثورة”، كانت مصائرُ الذين حَمَّلُوا أنفسهم مثل هذه المهام في منتهى المأساوية. وانتهى الأمرُ بكثير منهم إلى الموت في غيابات السجون، أو تحت سياط التعذيب، أو على أعمدة الإعدام، أو معلقين على المشانق. وحتى الذين نجحوا منهم في الاستيلاء على السلطة السياسية فقد تحولوا إلى مستبدين، ومارسوا من البطش والقهر والقمع أكثر مما كانوا يزعمون مناهضتَه والثورةَ عليه في السابق.
لقد حمل كارل ماركس هَمَّ تحرير العمال فكان مصيره أن عاش حياة غارقة في البؤس. ولولا السخاء الشخصي لصديقه فريدريك إنجلز لمات من الجوع ولماتت ابنته من بعده، هي الأخرى، من الفاقة والضَّيم. وراهن لينين على توحيد عمال العالم فقضى معظم حياته طريداً، شريداً، منفياً، وسجيناً، ومات معزولاً ومهمشا ومنبوذا من طرف أقرب المقربين إليه بعد أن استفحل مرضُه في السنوات الأخيرة من عمره القصير. وقبل هذا بقرون طويلة سعى أفلاطون إلى تحرير عقول الأثينيين من خلال الفلسفة، وأسس الأكاديمية، وظل يسير في الأرض غارقاً في تأملاته من أجل مستقبل أفضل وأجمل للأثينيين وللإنسان، فسقط في بركة ماء وهو شارد الذهن ومات غرقاً. وحمل عبد الناصر والقذافي وصدام حسين دعاوى “تحرير” و”توحيد” العرب فمات الأول مهزوما منتكساً بعد أن أذاق الشعب المصري كل ألوان القمع، ومات الثاني بأيدي الليبيين بعد اثنين وأربعين عاما من الاستبداد الأخرق والأحمق، وانتهى الثالث على حبل المشنقة بعد خمسة وثلاثين عاما من الاستبداد، وبعد أن دمر بلاده وشعبه كما يجدُر بأي دكتاتور يستحق اسمه.
بإمكاننا أن نُورد بدل المثال الواحد عشراً. فالتاريخ يزخر بأسماء الذين كانت لهم مطامحُ ومآلاتٌ مماثلة. بّيْدَ أن الغاية هنا ليست هي سرد الأمثلة بقدر ما هي أن نلاحظ، بالتواضع اللازم معرفياً وأخلاقياً، أن الذين يتحررون بالفعل هم الأفراد الذين يريدون التحرر. أما الجموع التي تحتشد وراء “الزعماء” و”القادة” فهي لا تصنع أي واقع تحرري. وهذا لا يسري فقط على ما يوصَفُ عادةً ب”الشعوب المتخلفة” وإنما هو ينسحب حتى على أكثر لحظات التاريخ الإنساني تجسيداً لفكرة الحرية والتحرُّر. ويكفي أن نستحضر هنا أن الثورات الحديثة في أوروبا قد أنتجت، في مخاضاتها المؤلمة والعسيرة، نماذج مثل نابليون بونابارت، وأدولف هتلر، وموسوليني، وقبل هؤلاء جميعاً فهي قد أعطت أبشع مظاهر استغلال الإنسان للإنسان في الزمن الرأسمالي الأول، وأنتجت الاستعمار والمذابح والدمار الذي بلغ حدَّ استخدام السلاح النووي في هيروشيما وناكازاكي. ولربما كان من مفارقات الأزمنة الحديثة أن عصر الأنوار قد أفرز الإمبريالية، بحروبها الطاحنة في القرن العشرين، والتي صنعت أكبر مأساة عرفها التاريخ الإنساني.
ومقابل هذا الفشل على صعيد الدول والشعوب، والحشود، فقد نجح الفكر الأنواري على صعيد الفرد عالمياً. ومثلما أعطت ثقافة الأنوار أفرادا متحررين، متشبثين بحريتهم إلى أقصى الحدود، في ما يُنعَت عادة ب”العالم الحر”، فإنها أنتجت أفراداً من نفس الطراز حتى في ظل أكثر الأنظمة السياسية دكتاتورية، وشمولية، واستبداداً. ونحن نجد الفرد المتنور في أوروبا والولايات المتحدة مثلما نجده في الصين، وروسيا، وبلدان المنطقة الناطقة بالعربية، وأفغانستان، وإيران، وغيرها من المناطق التي يمكن اعتبارُها بمثابة “نقط سوداء” على صعيد الحريات العامة وحقوق الإنسان. ولربما كان في هذا ما يسمح لنا بالاستنتاج أن الحرية ليست رهاناً قطيعياً وإنما هي رهانٌ فردي خالص. وليس من مهام الفيلسوف، والأديب، والمناضل السياسي، وغيرهم، تحريرُ مَنْ يرفُضُ الحرية. ذلك أن الرهان التحرري لا يكمن في محاولة تحرير الذين اختاروا العبودية ـ بمختلف أشكالها ومستوياتها ـ وإنما هو تمكينُ الذين يريدون التحرر من وسائل وأدوات التحرر الذاتي، أي أن تحرير الفرد الذي يريد التحرر هو الرهان التحرري الفعلي، والناجع، والوحيد. وأملُ الإنسانية ليس في “الأمة” ولا في “الطبقة” ولا في “الحزب” ولا في “النقابة” ولا في “الجمعية”. فكل هذه المؤسسات تنتهي بإنتاج القُطعان وتتحول في آخر المطاف إلى إسطبلات وحظائر تنتج الدواجن، والأنعام، والدواب. بل إن أمل الإنسانية يكمن في الفرد التوَّاق إلى الحرية، والذي لا يمكن أن يتنازل عن حريته أبداً.
الحرية ليست للقطيع!