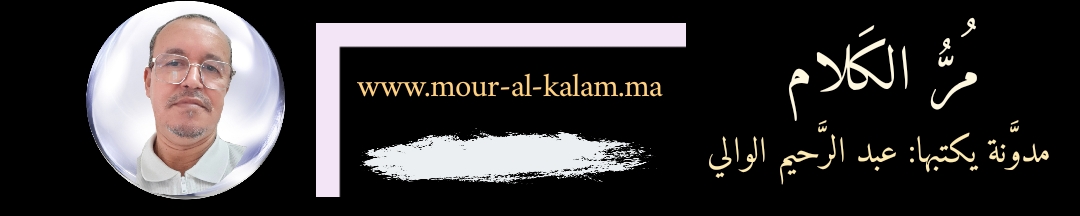لو قُدِّرَ لك أن تسأل شيخاً أو فقيهاً عن مكانة العمل في الإسلام لوجدت نفسك أمام خطبة عصماء لا تنتهي. والسبب في ذلك أن عدد الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، التي ترفع من شأن العمل والعاملين، وتدعو إلى التفاني في العمل وإتقانه، كثير. ولعل أول ما سيستشهد به الفقيه أوالشيخ في هذا الباب هو الآية التي تقول : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». ولن يتردد في القول بأن العمل هنا جاء بصيغة الأمر، وبأن ما ورد بصيغة الأمر يدخل في خانة الواجب الشرعي، وسيقول لك بكامل الوثوقية، وبمنتهى اليقين، بأن العمل واجبٌ شرعي.
أكثر من ذلك فالفقيه أو الشيخ سيعود بك إإلى الحديث النبوي الذي يقول بأن «العمل عبادة». وسيقول لك بأن كل عملٍ مفيدٍ يقوم به الإنسان، سواء كانت فائدته تعود عليه أو على غيره، أو عليهما معاً، يدخلُ في معنى العبادة وهو مما يُتَقرَّبُ به إلى الله. وقد يُتحفُك الفقيه أوالشيخ بتلك الواقعة التي يقال إن المسجد النبوي، بالمدينة المنورة، قد شهدها في زمن النبوة. ذلك أن النبي كان كلما دخل المسجد وجد فيه رجلا عاكفاً على العبادة فسأل عمن يعوله. ولما قيل له بأن الذي يعوله هو أخوه كان جواب النبي: «أخوه أعبد منه». وبالتأكيد، فإن الفقيه أو الشيخ سيقول لك بأن كلام النبي يستفاد منه هنا أن العمل سابقٌ على الصلاة والصيام وسائر العبادات الطقوسية.
ومثلَ أي إنسان يستخدم عقله فإن الفقيه أو الشيخ سيقول لك بأن الآية القرآنية التي تقول «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ليس معناها أن الله خلق الإنس والجن لكي يتفرغوا للعبادات الطقوسية، وإنما المقصود في الآية هو العبادة بمفهومها الشامل الذي يدخل ضمنه العمل، أي أن الله خلق الإنسان أولاً وأخيراً ليعمل.
والواقعُ أن مثل هذه الخُطب العصماء لا تنتظر أسئلتنا أصلا. بل إن الفقهاء والشيخ يَصُمُّون بها آذاننا صباحَ مساء. ولربما كان جزء مما تقدم أعلاه قد سمعتُه أنا نفسي من خطب الفقهاء والشيوخ والأئمة.
لكنْ، لو أنك سألت الشيخ أو الفقيه عن عمله هو نفسِه لأصابَه الخَرَس لأنه، بكل بساطة، لا يعمل. ومع التشديد على أنني لا أعني هنا مجموع الفقهاء في التاريخ الإسلامي، والذين كان منهم بالفعل مَنْ ظل يكسب قوته بعمل يده مثل الماوردي، فإن الأغلبية الساحقة من الفقهاء والشيوخ وأئمة المساجد لا تعمل سواء في الماضي أو في الحاضر. فمنهم من ظل يتخذ من الإفتاء للحكام عملاً، ومنهم من اتخذ من الخطابة لهم بما يريدون على منابر الجمعة عملاً، ومنهم من جعلَ مهنته قراءة القرآن في المناسبات، وما إلى ذلك، مع الاستفادة طبعاً من الإكراميات والأعطيات والهدايا دون بذل أي مجهود يُذكَر. والحال أن الاسترزاق بالقرآن، وبالدين عامة، وبالعبادات الطقوسية خاصة، لا أصل له في القرآن ولا في سنة النبي ولا في آثار الصحابة. فلا النبي كان يتقاضى أجرا عن إمامته للمسلمين في الصلاة، ولا سيدنا بلال كان مأجورا عن الأذان، ولا غيرُهُما من الذين عاشوا فجر الإسلام كان يتقاضى مقابلاً عن الصلاة أو الإمامة أو قراءة ما تيسر من الذكر الحكيم.
أما اليوم ف «المَشْيَخَة» و «الفَيْقَهَةُ» و«الإمامة» قد صارت كلُّها بمثابة أنشطة مدرة للدخل في أقل الأحوال أو حتى أنها تحولت، في أقصاها، إلى تجارة مربحة. ولا أدل على ذلك من مداخيل الأدسنس الطائلة التي يجنيها «شيخ» مثل المدعو ياسين العمري، والثروات الهائلة التي راكمها نجوم «الاستعراض الديني» من أمثال المدعو محمد حسان والمدعو عمرو خالد وغيرهما. وهذا أمرٌ مفهوم في زمن وسائل الإعلام الجديدة حيث تقول القاعدة «أنشئ محتوى وأنشئ حول المحتوى جمهوراً وستكافأ على ذلك». والمشكلة ليست في أن الشيخ أو الفقيه يصنع محتوى ويبيعه ويتلقى عنه مقابلا مثل سائر صُنَّاع المحتوى عبر العالم. بل المعضلة الكبرى تكمن في أن هؤلاء الفقهاء والشيوخ يتقاضى عدد منهم مالاً لُبَداً لكي يُشيع في الناس الكسل، والتقاعس، والتواكُل، ويشحن رؤوسهم بالخرافات. وكثيرٌ منهم يتلقى المكافآت الضخمة من جهات بعينها ليس من مصلحتها أن تقدس الشعوب المُسْلِمَةُ العمل، ولا أن تقَدِّمَه على العبادات الطقوسية مثلما هو مُقدَّمٌ عليها بالفعل شرعاً. بل إن تلك الجهات من مصلحتها تماماً أن تظل تلك الشعوب حبيسة الفهم القَدَري، الاستسلامي، التقاعسي، للدين؛ ذلك الفهمُ الذي يبخس الدنيا، ويحث الناس على الاكتفاء منها بالأكل والشرب واللباس والنكاح باعتبار ذلك هو الأفق النهائي لوجودهم، مع الإكثار من العبادات الطقوسية ومظاهر التقوى والإيمان. وبدل أن يكون الدين حافزا على العمل، والإتقان، والإنتاجية، فهو يتحول في شقه المظهري، الطقوسي، إلى وسيلة للغش والخداع، واستغباء الزبائن، والتملص من الواجب الوظيفي في المرافق العمومية، وما إلى ذلك من التجليات السلبية.
والأمر لم يعد اليوم مجرد ممارسات معزولة وإنما صار منظومة أنطولوجية متكاملة حيث يريد المسلمون ـ في أغلبهم ـ أن يعيشوا دنياهم للأكل والشرب والنكاح والعبادات الطقوسية، المناسباتية، فقط. وهم يطمعون بعد الموت أيضاً أن يدخُلُوا الجنة ليُحَلَّواْ أساور الذهب والفضة، ويلبسوا ثياباً من سندس وإستبرق، ويتكئوا على الأرائك بعد أن قضوا حياتهم الدنيا متكئين بشكل أو بآخر. ولربما نجح هؤلاء الشيوخ والفقهاء في نحت كوجيتو جديد لعموم المسلمين: “أنا متكئ إذن أنا موجود”.
حسناً! اتكئوا فإنَّا معكم متكئون.