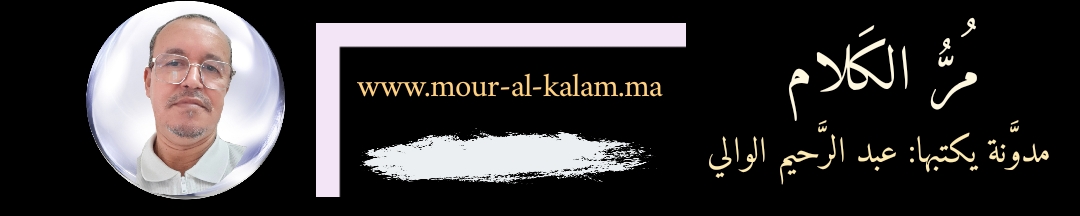في كتابه الرئيس “العالم كإرادة وكتَمَثُّل”، يتوقف أرثور شوبنهاور عند ”مبدأ التفريد”. وهو كما يقول من بين المبادئ التي كثيرا ما توقفت عندها الفلسفة الرواقية. وهذا المبدأ، الذي لم يسمع به ربما غير المختصين في الفلسفة، لا يعني أي شيء معقد أو يستعصي على الفهم كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما هو يحيل فقط على ما يميز الفرد ويجعله فرداً. والمقصود هنا بالفرد ليس فقط الفرد من النوع البشري، وإنما هو الفرد على الإطلاق، وضمن جميع الأنواع.
وبالنسبة لشوبنهاور فمبدأ التفريد هو تجسيدٌ للإرادة كقوة ميتافيزيقية. فهذه القوة غير الواعية، التي تتجلى في جميع الموجودات، هي التي تنزع إلى تمييز الفرد. وهذا التمييز مرتبط بارتقاء النوع الذي ينتمي إإليه في سُلَّم الكائنات. فعندما يتعلق الأمر بالجمادات نجد أن الأفراد يتشابهون إلى درجة تكاد تصل حدَّ التطابق. ونحن نرى ذلك مثلا في الصخور واالأحجار وغيرها من الجمادات، حيث لا تكاد تتميز صخرة عن صخرة أخرى من نفس النوع، ولا يكاد يتميز حجرٌ عن حجر من النوع ذاته. وأمَّا حين ندخل مملكة النبات ـ وهي طبعا أرقى من الجماد ـ فإننا نعثر على تمايزات واضحة بين شجرة وأخرى، وبين وردة وغيرها، وبين زهرة وأختها. ثم نجد أن الفوارق بين الأفراد قد صارت أكثر وضوحا عندما نَلِجُ مملكة الحيوان. وهي، بالطبع، أرقى من مملكة النبات. فنرى كيف يتميز كلبٌ عن كلب من نفس الفصيلة، وكيف يختلف قط عن قط، وثور عن ثور، وما إلى ذلك. وكلما ارتفعنا داخل مملكة الحيوان نجد أن الفرد قد صار أكثر تميزا إلى أن نصل إلى الأنواع الحيوانية العليا. وهذا ما أكده أيضا عالم الإيتولوجيا (علم سلوك الحيوان) الأمريكي من أصل هولندي، فرانز دو ڤال، في كتابه عن “السياسة لدى قردة الشمبانزي”، بعد أكثر من قرن على ملاحظات شوبنهاور، حيث بيَّن أن الفرد لدى هذه القردة يشكل كيانا متميزا بكل معنى الكلمة، وينفرد بمجموعة من الخصائص عن غيره، بدءً بالمواصفات الجسدية وانتهاءً بالجانب النفسي والسلوكي. وبالطبع، فإن التفريد يصل مداه الأقصى عند الإنسان حيث يصبح الفرد بمثابة وجود مستقل، قائم بذاته، من الناحية الأنطولوجية والنفسية السياسية أيضا.
رُؤية شوبنهاور هذه معناها أن الإرادة، كقوة موجودة في الطبيعة، هي التي تنتج الفرد. وهي التي تسير بالإنسان ـ باعتباره أعلى الكائنات الأرضية ـ نحو التمييز المستمر للفرد، ونحومزيد من استقلاليته، أي من انفراده، ومن تَفَرُّده أيضا. ففي تلك الاستقلالية، وفي ذَيْنَكَ الانفراد والتفَرُّد، تتحقق إنسانيتُه. ومتى تخلى عن استقلاليته، وعن انفراده وتفَرُّده، وغاص وسط الحشود، تدنَّى نحو الحيوانية وترَدَّى في غيابات البهيمية. وهذه الحالة بالضبط هي التي تَوقَّفَ عندها غوستاڤ لوبون في كتابه الشهير “سيكولوجيا الحشود”، الذي يترجمه البعض إلى “سيكولوجية الجماهير” كعادة العرب في “إبداعاتهم” أو لنقل في “إفداعاتهم” التَّرجَمِية. وهي الحالة عينُها التي استوقفت لاحقاً سيغموند فرويد وهو يستحضر غوستاڤ لوبون في كتابه “سيكولوجيا الحشود وتحليل الأنا”. فهما معاً يَرَيَان أن الإنسان ما أن يصير جزءً من الحشد حتى يتقهقر عدة درجات على سُلَّم الحضارة. وهو، حين يكون منعزلاً، قد يكون مثقفاً. أما داخل الحشد فهو يحتكم إلى غرائزه، وبالتَّبِعَة فهو يغدو متوحشا. وتصير له تلقائيةُ، وعُنفُ، وشراسَةُ البدائيين، وكذلك حماستُهم ونزوعهم إلى “البُطولة”.
مما لا ينتطح فيه عَنْزَان، ولا “يَتَهَارَشُ” فيه كَلْبَان، أن كل ما ذكرتُه أعلاه لا يغيب عن الأنظمة التحكمية، القائمة على القهر والاستبداد، أو حتى على الاستعباد. فلتلك الأنظمة أيضا فلاسفتُها، وخبراؤها النفسيون، وأجهزتها التي تسمع ما لا أُذُنٌ من آذاننا سمعت، ولا عينٌ من عُيُوننا رأت، ولا خَطَرَ على قلب أيِّ واحد منا نحن معشر الكادحين. وهي أنظمة تنفق على اساليب التحكم، بالطبع، أضعافَ ما تنفقه على التنمية، أو على ما تسميه كذلك. وبحكم كل ذلك فهي تعرف أن الخطر الأكبر عليها يكمن في وعي الفرد بتميُّزه كفرد، وفي استقلاليته، وفي تفرًّده. ولذلك فهي تعمل عكسَ عَمَل الإرادة كقوة ميتافيزيقية. وعوض التفريد فهي تعمل بكل الوسائل على “التَّحْشيد”، أي على إبقاء الفرد جُزءً من الحشود.
وفي سبيل ذلك فهي تسخر “الشيوخ” و”الفقهاء” والجماعات الظلامية، وتوظف التفاهة والرداءة لمحاربة الذوق الرفيع وتحطيمه، وتصنع “الزعماء” الطَّرَاطِرَة وتنشىء لهم “أحزابا” و”نقابات” و”مراكز” وتمدهم بالأموال، وبجميع الوسائل الضرورية، لاستحمار واسْتِبْغَال واستِمْعَاز الحُشود. وهي حريصة أشدَّ ما يكون الحرصُ على كل ما ينتج “التَّحْشيد” ويُشِيعُه ويُفْشيه حتى وإن اقتضى الأمرُ تجييش أنصار الفرق الرياضية وتحويلهم إلى ميليشيات مسلحة. بل ويمكننا أن نرى تجليات “التَّحشيد” حتى في الهندسة المعمارية، حيث تعمل آلياتُ الاستحمار والاستبغال والاستمعاز على حرمان الفرد من أقل الشروط التي يمكن أن تحقق استقلاليته. ففي المدن “العربية”، المترامية من الماء إلى الماء، تحرص الهندسة المعمارية للأحياء الشعبية على بناء “شقق اقتصادية” يستحيل أن يحصل فيها الفرد على غرفته الخاصة، ولا تفصل فيها بين غُرَف نوم الآباء والأمهات ومكان نوم الأبناء إلا جدرانٌ يتحقق فيها شرطُ “الشفافية الصوتية” الكاملة، وتكاد تستحيل معها، بالمُقابل، الحياة الحميمية الكاملة للزوجين. فلا يكاد المرء يحظى في بيته بلحظة عشق إلا “حُلُماً في الكَرى” أو في ما يشبه “خلسة المُختلس”. وبالتأكيد، فكلما انعدمت الحميمية كثُرَت “البَرْقَقَة”، أي ما نسميه في دارجتنا المغربية “التبرگيگ”، وانمحت بالنتيجة خصوصيةُ الفرد الذي يجد نفسَه في النهاية ـ بوعي أوبدونه ـ منخرطاً في الحشد، ويقُودُه سياسياً (أو هو بالأحرى “يُقَوِّدُه” سياسياً!) “شيخٌ” أو “فقيه” أو”زعيم”، أي طَرْطُور.