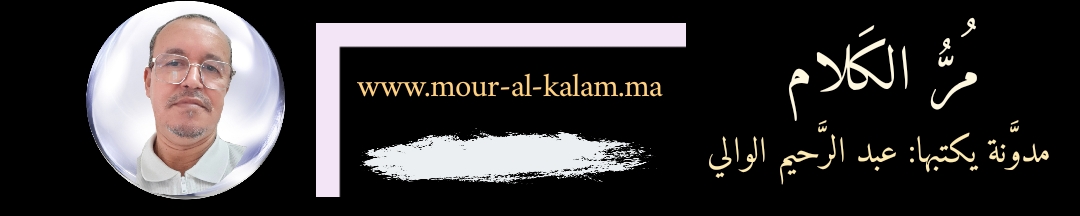بينما كنت أتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي طلع عليَّ، لسبب لا أعرفه حتى الآن، شريطٌ سبق لي أن شاهدتُه قبل الآن، عدة مرات، أي أنه فُرِضَ عليَّ من طرف خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي دون رغبة ولا إرادة مني. وفي هذا الشريط تجلس جماعة من مواطني بلدٍ ما من بلدان الخليج، في صالون فسيح مُريح، بينما جماعة أخرى تحمل طبقاً بمساحة غرفة من غُرَف السَّكن الاقتصادي لدينا. وفي وسط الطَّبَق جَمَلٌ بالكامل يحيط به ما يعادل حمولة شاحنة من الأُرْز. وبعد أن وُضع الطبق أحاطت به فئة من الجالسين وشرعوا في التهام الأرز ونهش لحم الجمل. ولا شيء بعد ذلك!
لا أعلمُ ما علاقتي بالخليج، ولا بالجِمال، ولا بالأكل بتلك الطريقة. فأنا مغربي أباً عن جد. ولا صلة لي ـ ولا حتى لمَنْ أعرف من أسلافي ـ بتربية الإبل. ولا علاقة لي بالأكل بتلك الطريقة لأنني ولدت ونشأت في الوسط الحضري حيث تنعدم ـ أوتكاد ـ أجواء العائلات الممتدة التي تلتئم حول الأطباق الكبيرة بتلك الأعداد الهائلة. وبعد أن شاهدتُ الشريط ظل ذلك السؤال الذي طرحه الفنان الكوميدي اليمني، محمد الأضرعي، يتردد في أذني: “إيش استفدت أنا وإيش استفادت الأمة؟”
وما كدتُ أتجاوز الأمر حتى طَلَعَ عليَّ شريطٌ آخر، فيه هو الآخر أحد الملتحين بلباس خليجي، يتحدث عن قرب نهاية العالم. ويعيد نفس الأساطير التي سمعناها وقرأناها منذ الثمانينيات ونحن إذَّاكَ تلاميذ في المرحلة الثانوية: اقتراب الساعة، وهروب اليهود، واختباؤهم خلف الأحجار والأشجار التي ستصيح: “يا مُسلم! هذا يهودي ورائي فتعال اقتُله!”. ومرة أخرى وجدتُ نفسي أتساءل عن علاقتي بهذه الأساطير وعن السبب الذي جعل خوارزميات الموقع تقترح علي مشاهدة هذه التخاريف. فلا أنا يهودي، ولا أنا من الذين يريدون قتل اليهود ولا غير اليهود، ولا علاقة لي من قريب ولا من بعيد بقاموس القتل والعنف. بل أنا إنسانٌ مُسَالِمٌ إلى أقصى الحدود.
غير أنني، بعد نهاية الشريط الثاني، لم أطرح السؤال المستعار من محمد الأضرعي. بل وجدتُني أتساءل عن العلاقة بين الجمل العائم في مسبح الأرز، في الشريط الأول، والأساطير التي كان يرددها ذلك الملتحي في الشريط الثاني. وسألتُ نفسي عما يفعلُه كل واحد من هؤلاء الذين جلسوا لالتهام الأرز ونهش لحم الجمل المسكين. فكان الجواب أنهم جميعاً يفعلون ما نفعلُه جميعاً. وجميعُناَ، بالتأكيد، لا يفعل شيئا على هذه الأرض غير الاستهلاك: استهلاك الأكل واستهلاك الخرافة بشكل من الأشكال. وعادت بي الذاكرة إلى ما يزيد عن عشرين سنة خَلَت، حينما كنت ما أزال أعمل في الصحافة، وكان مقر الجريدة التي كنت أعمل بها في عمارة يوجد في أسفلها مستودع للبضائع الصينية.
كان يسهر على المستودع الضخم بأكمله شاب صيني واحد. وربما كان فضولي الصحفي، أو شغفي بالحضارة الصينية، هو الذي دفعني إلى ملاحظة ما كان يفعله ذلك الفتى الصيني. فقد كان يشحن البضائع على متن عربة صغيرة مدفوعة. وبعد أن يُخرج العربة المشحونة من المستودع كان يوقفها بالقرب من الباب. ثم يغلق الباب ويتسلقه من الخارج، ويمد يده إلى الداخل لإقفاله، ويقفز بعد ذلك برشاقة إلى الأرض، ثم يدفع العربة ليوصل الشحنة إلى المتاجر الصينية التي كانت آنذاك تنتشر في منطقة درب عمر، على مسافة غير يسيرة من المستودع. وبعد أن يعود بالعربة فارغةً كان يسندها على باب المستودع ويحولها إلى سُلَّم يصعد عليه ليمُدَّ ذراعه من جديد إلى الداخل ويفتح الباب، ثم يستأنف نفس العملية من جديد.
نعم، كان شاب صيني واحد، ووحيد، بقامته القصيرة وجسده النحيف، يقوم بعمل ثلاثة أشخاص على الأقل. وبينما كنت ذات يوم أغادر مقر الجريدة صحبة رئيس التحرير آنذاك، الأستاذ أحمد بوكيوض شفاه الله، تصادف مرورنا مع مجيء الشاب الصيني. فاستوقفتُ السي أحمد وطلبتُ منه أن يلاحظ ما سيقوم به. وبعد أن انتهى الشاب الصيني من إخراج البضائع وإغلاق المستودع نظر إلي السي أحمد بوكيوض ضاحكاً وهو يبدي إعجابه بالطريقة التي استخدم بها العربة. فقلت له إن هذا هو الإنسان الصيني. وليس من المستبعد أن يضيف خلال الليل إسفنجة إلى العربة ويحولها إلى سرير للنوم. ثم ضحكنا معاً وانصرفنا.
وبالفعل، فذاك هو الإنسانُ الصيني الذي يتطلع اليوم إلى زعامة العالم. وكل من درس التاريخ يعرف أن الصين كانت ـ إلى حدود سنة 1949 ـ بلداً غارقاً في التخلف، محكوماً بالخرافات الموروثة عن العصور البائدة، مُثْقَلاً بعدد هائل من السكان، غارقا في الفقر والبؤس. لكن الثورة الثقافية التي قادها ماو تسي تونغ حررت الإنسان الصيني من كل تلك الخرافات، وقضت على الأمية، ونشرت المعارف المعاصرة، وأشاعت العلوم والتكنولوجيا، فكانت النتيجة هي الصين كما نراها اليوم. والسر لا يكمن في الأموال الطائلة، ولا في بحور النفط التي تسبح فوقها دول الخليج وغيرها من الدول الناطقة بالعربية، وإنما هو يكمن في الإنسان الصيني الذي يتناول وجبة تتكون من وعاء من الأرز، بحجم كف اليد، ولا يتجاوز وزنُه في المتوسط ستين كيلوغراماً، لكنه يعمل الساعات الطوال بانضباط وتفانٍ، عكس العرب والناطقين بالعربية. فكل واحد منهم يأكل ما يأكله عشرة صينيين، وربما يتجاوز وزنُه وزن ثلاثة مواطنين صينيين أيضا، ولا يصنع شيئا مما يصنعه الصينيون باستثناء ما يذهب إلى قعر المرحاض. وعوض أن يرى الحاجة إلى ثورة ثقافية تحرره من الخرافات، فهو ما يزال يسلم عقله لأمثال ذلك الملتحي الذي كان عليَّ أن أتحمل قَرَفَه في الشريط الثاني، ليتغوطوا فيه. والعجيب أن هذا الإنسان الكسلان الخامل ما يزال يحلم بحرب كونية يخرج منها منتصرا على العالم أجمع. ولا أعرف ـ حتى إذا ما قامت هذه الحرب فعلا ـ بماذا سينتصر: هل بأكل الأرز بتلك الكميات الهائلة؟ أم بنهش لحم البعير على ذلك النحو الهمجي؟ أم بقنابل الغاز التي يُنتِجُها بعد اختلاط هذا وذاك في بطنه؟