لديَّ على الهاتف تطبيقٌ هو عبارة عن قاموس متعدد اللغات. وبالطبع، فأنا أستعين به كلما أشكل عليَّ أمرُ كلمةٍ ما سواء في لسان العرب أو في ألسنة غيرهم. وفي هذا القاموس، كغيره من التطبيقات المماثلة، خيارٌ يمكِّنُ المستعمل من سماع الكلمة أو الجملة منطوقةً بصوت نسوي جميل. ولأنني كنت مُتعباً، ربما، فعوض أن أبحث عن “الشيخ بنحمزة” على محرك غوغل كتبتُ العبارة على القاموس المذكور. وعوض أن أضغط على زر البحث ضغطتُ على زر الترجمة. ولم أنتبه إلا وذلك الصوت النسوي الجميل ينطق عبارة ال”شِّيك بِنْهَمْزَة”.
كنتُ في حاجة إلى البحث عن الشيخ بنحمزة لأنني لا أعرفه. وباستثناء ظهوره، في فترة ما، على شاشة التلفزة للإجابة عن أسئلة الحيض والنفاس وما شاكلها، فأنا لا أعرف عنه شيئا سوى أنه قد تم تعيينه مؤخرا رئيسا للمجلس العلمي لجهة الشرق من طرف الملك محمد السادس. وما عدا هذه المعطيات الضئيلة، فلا شيء في ذاكرتي عن الرجل اللهم خروجُه في الآونة الأخيرة لمناهضة التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
عملية البحث عن الشيخ بنحمزة أفضت بي إلى معطيات وافرة حول مساره الأكاديمي، سواء في اللغة العربية وآدابها أو في مجال الدين، والذي يبقى مسارا حافلاً ومحترماً. وبالنظر إلى المسار إياه فلربما كان من المفروض أن يكون الشيخ في طليعة مَنْ يقودون تحديث الفقه الإسلامي في المغرب عوض أن يكون من دعاة الجمود والتحجر ورفض التطور والتجديد. وحسب ما قرأت وما سمعت في بعض حوارات الشيخ المرئية فهو يرفض رفضا قاطعا أي تجديد في ما يتعلق بقوانين الإرث. وقد بلغ به الأمر حدَّ طرح السؤال الاستنكاري: “هل أخطأ الله في تقسيم الإرث؟”
كلاَّ وحاشا وما ينبغي للمرء المؤمن أن يفكر في الله على هذا النحو ولا حتى أن يطرح هذا السؤال ولو على سبيل الاستنكار. وعوض التَّمَتْرُس خلف الفهم الجامد، المتقادم، للنص القرآني، كان بإمكان فضيلة الشيخ أن ينظر إلى الموضوع في علاقته بالمقاصد والغايات الكبرى، والسامية، للشرع. ولو أنه أمعن النظر، وأعْمَلَ العقل كما ينبغي لشيخٍ في مقامه، لوجد أن المرأة قبل الإسلام لم تكن تُوَرَّثُ عند العرب فجاء القرآن ليعطيها نصف ما يرثُه الذكر. وبذلك فقد كانت غايةُ الشرع الآنية، في ذلك الوقت، أن يرفع الحيف عن المرأة وأن ينصفها من الظلم الذي كان لاحقاً بها في المجتمع العربي قبل الإسلام بإعطائها نصف حظ الذكر من الإرث. أما غايتُه البعيدة، الكبرى، والمُثْلى، فهي مطْلَقُ الإنصاف ومُطْلَقُ العدل دون تقييد بالنصف أو بغيره. ولا شيء في القرآن يقول بأن الأحكام القرآنية جامدة وغير قابلة للتطور. بل ربما كانت الحكمة من نزول القرآن مُنَجَّماً، أي بالتدريج عوض أن ينزل دفعة واحدة، هي بالضبط مواكبةُ التطور ومسايرة الحاجيات التشريعية للمجتمع الإسلامي الناشئ.
والشيخ بنحمزة لا يستطيع بحال من الأحوال أن يُنكر أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً، وأن كثيرا من الأحكام القرآنية قد ألغاها القرآنُ نفسُه استجابة لمقتضيات التطور الاجتماعي. ولا هو يستطيع أن يُنكر أن التجديد في الدين من المرتكزات الأساسية في الإسلام. فالقرآن ظل يتجاوب مع متغيرات الحياة طيلة السنوات الثلاث والعشرين التي استغرقها زمنُ النبوة، فنَسَخَ آيات بآيات غيرها، وبدَّل أحكاماً بأحكام، واستجاب بطريقة خلاقة لمستجدات الواقع الاجتماعي وقضاياه الراهنة في ذلك الوقت. وإذا كان القرآن قد فعل هذا خلال ثلاثة وعشرين سنة فقط فكيف بما يقارب خمسة عشر قرناً من الزمن؟ وكيف يريد لنا بنحمزة أن نحتفظ بأحكام تعود إلى قرون خلت؟
نفسُ ما يحدث في ما يتعلق بقوانين الإرث يحدث في ما يخص مسألة تعدُّد الزوجات. وهنا أيضا لا يريد خندقُ الجمود أن يفهم النص القرآني كما هو، في كليته وشموليته، ويجتزئ منه فقط تلك الجملة التي تقول “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”. وهو لا يريد أن يرى أن المعنى يبتدئ على النحو التالي في سورة النساء: “وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حُوباً كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانُكم. ذلك أدنى ألا تعولوا”.
فيكفي أن نعرض النص على تلميذ نبيه سبق له أن درس الشَّرط وجوابَه في اللغة العربية لكي يرى أن جملة “فانكحوا…” هي جوابٌ لشرط سابق: “وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى”. وتكفي العودة إلى تفسير ابن كثير للوقوف على سبب نزول الآية، وليتبين أنها نزلت خصيصا في الوصي المُشرف على مال اليتيمة، والذي يتزوجها ويضم مالها إلى ماله، بما في ذلك من حيف. وحين قال “مثنى وثلاث ورباع” فقد ربط ذلك بشرط العدل. وهو الشرط الذي نفاه في نفس السورة من خلال الآية التي تقول: “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم”. فغاية الشرع – مرة أخرى – لم تكن هي إباحة التعدد. بل إن هذا القول يمثل قمة العبث لأن التعدد كان في الأصل مباحا قبل الإسلام دون تقييد. وجاء القرآن ليقيده بشرط العدل، وليجعل هذا الشرط مستحيلا بالنص الصريح لاحقاً. وبالتالي فالغاية كانت هي الحد من التعدد وإسقاطه.
ولربما كان في هذه الآيات التي أوردناها من سورة النساء خير دليل على ضرورة مسايرة التطور. فالآيات تتحدث عن “ما ملكت أيمانكم”، أي عن الجواري والإماء اللائي كان الرجل يشتريهن من سوق النخاسة بماله لخدمته، وكان يجوز له أن يتخذ منهن أيضا موضوعاً جنسياً. وهذا واقع قد تجاوزه التطور اليوم بعد أن تم إلغاء الرق وتجريمُ الاتجار بالبشر. فهل سيعارض الشيخ بنحمزة أيضا هذا التجريم؟ وهل سيخرج ليقول لنا: “هل أخطأ الله حين أباح نكاح المملوكات؟”
مرة أخرى سيكون جوابي هو كلاَّ وحاشا. فالله منزه عن الخطأ. والقرآن في هذه العبارة كان يتحدث عن عصر كانت ما تزال توجد فيه الإماء والجواري، ولذلك تحدث عن إمكانية نكاح “ما ملكت الأيمان”. أما اليوم فقد صار استعبادُ الإنسان أو الاتجار فيه جريمة. ولا مانع، قياسا على ذلك،من أن يصير التعدد جريمة، وأن يصير تزويج القاصرات جريمة، وأن يتم تحقيق الغاية الشرعية المثلى بإنصاف المرأة ومساواتها مع الرجل في الإرث. فغاية الشرع تحقيق المصلحة.وحيثما كانت مصلحةُ الإنسان فتمَّ شرعُ الله.
لربما كان الشيخ بنحمزة غاضبا لأنه هذه المرة، خلافا لسنة 2003، لم يتم إشراكُه في لجنة تعديل المدونة. ولربما كان غاضبا أيضا لأنه ـ حسب ما قرأت ـ كان مرشحا لمنصب وزير الأوقاف وضاعت منه “الهمزة”. ولكن هذا لا يبرر الوقوف في وجه التطور والاجتهاد ضدا على مصلحة المجتمع والدولة معاً. فالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان لا تقبل التمييز ولا تعترف ب”مِلْكِ اليمين”. وما على الذين لا يزالون في زمن “مِلْكِ اليمين” إلا أن ينكحوا أيمانَهم الفارغة ويلوذوا بالصمت!
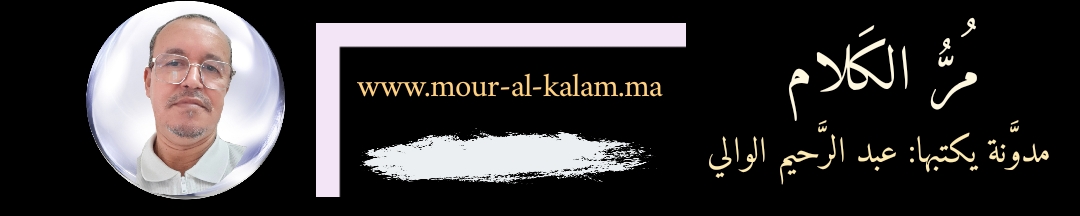
السلام عليكم سي عبد الرحيم
الف مبروك على هذه المدونة اتمنى لها ولك كامل التوفيق.
شكرا لك صديقي العزيز.