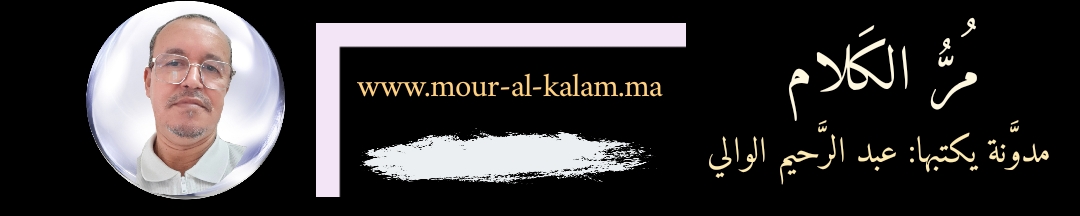ثمة لحظة تستوقف، على الأرجح، أغلب قُرَّاء محاورة “فيدروس” لأفلاطون. وهي اللحظة التي يسأل فيها الفتى فيدروس مُحاوِرَه الشيخ سقراط عما إذا كان المكان الذي يجلسان فيه، على ضفة نهر أليسوس، هو نفس المكان الذي يقال بأن الإله بورياس اختطف فيه الفتاة أوريثيا. ولعل ما يستوقف القارئ، في هذه اللحظة بالذات، هو الجواب الذي يقدمه سقراط.
فهو يقول أولاً بأن الفتاة، بكل بساطة، كانت تلعب مع صديقتها “فارماكيا” فدفعتها ريح الشمال بعيدا عن صخور الضفة وماتت غرقاً. ومن ظروف موتها بتلك الطريقة المأساوية نشأت الأسطورة التي تقول بأن الإله بورياس قد اختطفها. وثانياً، فهو يعلن موقفاُ صريحاً من الميتولوجيا حين يقول بأنه لا يفكر في شخوصها ولا في الأحداث التي ترويها، وإنما هو يستبعدها، ويفكر، بالمقابل، في نفسه.
ما أهمية ذلك؟
ينطوي الموقف السقراطي على بُعدين أوَّلُهُما التفسير المنطقي لأحداث التاريخ بعيداً عن الميتولوجيا، وثانيهما التفكير في الذات بدل الانسياق وراء الكائنات والمرويات الأسطورية. وبين الاثنين، أي بين البعد الأول والثاني، ينتصب جامعٌ هو العقل الذي يفكر في التاريخ وفي الذات معاً خارج النطاق الذي ترسمه الميتولوجيا. فهنا، بالضبط، تكمن وظيفة الفلسفة ومهمة الفيلسوف: تحرير الإنسان من الفهم الأسطوري لتاريخه ولذاته. وعوض التفكير في الكائنات الأسطورية مثل الحصان المجنح (Pégase) فإن سقراط يعلن أن الأجدر والأولى به أن يفكر في نفسه لأن التفكير في مثل تلك الكائنات يعتبر مضيعة للوقت ليس إلا.
كان هذا في ما بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد.وهذه اللحظة، في محاورة “فيدروس”، تجسد ذلك الانفصال الذي يُعَبَّرُ عنه عادةً ب”خُروج اللوغوس من الميتوس” أو “انفصال اللوغوس عن الميتوس”. وهو الانفصال الذي يُدَرَّسُ عادةً للمبتدئين في الفلسفة على سبيل تمييز التفكير الفلسفي عن النمط السابق عليه من التفكير، أي التفكير الميتولوجي. ومع أنني أعرف ما تثيره ترجمة “الميتولوجيا” إلى “الأسطورة” لدى البعض فإني أحتفظ هنا بهذه الترجمة رغم ما قد يعتريها من عدم الدقة. ذلك أننا، في العُشَرية الثالثة من القرن الحادي والعشرين، ما تزال عقولُنا ـ مع الأسف الشديد ـ أسيرة الأساطير، أو لنقُل إنها ما تزال أسيرة التخاريف، بل أسيرة الأكاذيب التي ما يزال الناس مصرين على تصديقها رغم أنهم يعرفون أنها محضُ أكاذيب. وعوض أن يعمل مَن يسمي نفسه ب”الفيلسوف” على تحرير عقول الناس من الخرافات، والأوهام، والشعوذة، فإنه ينخرط في نشرها، ويصير واحدا من نُشَطاء “الإطارات” التي تُفْشيها وتُروِّجُها.
وبدل أن يرى هذا الذي يسمي نفسه “فيلسوفاً” أن الشر يكمن في الارتهان إلى تلك التخاريف البائدة، التي تكرس التخلف، وتجلب الويلات واالخراب والدمار والموت على الأبرياء، فهو يساهم في تعزيزها وترسيخها وإضفاء “الشرعية الفلسفية” عليها. فالشر المطلق ليس حربا تقوم في مكان وزمان ما مهما خلفت من ضحايا ومعطوبين ويتامى وأيامى وخراب. والشر المطلق ليس أن يجوع المرء أو يعطش أو يفتقد الأمان لفترة من الزمن. بل الشر المطلق فكرةٌ فاسدة، تدخل العقل فتفسده، وتمتد إلى السلوك فتفسده أيضا.
الشر المُطلق – يا من تزعم لنفسك صفة “الفيلسوف” وأنت غارق في الخرافة حتى الأذنين! – أن تبيع للضعيف وهم القوة وتدخله في مواجهة خاسرة، وأمرُها محسومٌ حتى قبل وقوعها. الشر المطلق أن تزرع في ذهن طفل أو شاب، في القرن الحادي والعشرين، أساطير هدامة تقوده إلى الهلاك وهو يتوهم أنه يصنع الانتصار. الشر المطلق أن توهم إنسانا يعيش في زمن الذكاء الاصطناعي أنه يستطيع كسب حرب بالاعتماد على ما يَعِدُ به التأويل الساذج لبعض النصوص الدينية. ومُطْلَقً المُطْلَقِ في هذه الحالة أن تُوَسِّلَ الفلسفة لخدمة الخرافة ولمزيد من إفساد العقول.
لعلنا اليوم في أمس الحاجة إلى ما يُدخلُنا في صُلب تلك اللحظة السقراطية التي تحدثتُ عنها أعلاه. فقد استهلكت شعوب المنطقة الممتدة من المغرب إلى اليمن ما يكفي من خَدَرِ الأساطير، وبِيعَتْ لها كُلُّ أصناف الأكاذيب، واحتشدتْ قُطعاناً قُطعاناُ وراء باعة الأباطيل من زعماء ونُقَباء ودجالين يُنْعَتُون كذباً ب”العُلماء” وغيرهم. لكنهاـ طيلة ما يزيد عن قرن حتى الآن ـ لم تحصُد بفعل ذلك غير الهزائم والخيبات والدمار ومزيدٍ من الغرق في مستنقع التخلف والجهل والظلام. وهي تحتاج اليوم، بالفعل، إلى أن تتحرر من سطوة الأوهام التي بيعت لها طيلة هذا الوقت. والتحرر المقصود هنا ليس، بالطبع، حالة قطيعية تُكَرِّسُ أولوية “الزعيم” و”الفقيه” و”المثقف” وغير هذا وذاك من عشاق الفنطازيا اللسانية. بل إن التحرر الحقيقي يكمن، كما سبق أن قلت خلال مناسبات أخرى، في تمكين الفرد، تربوياً، من استقلاله واستقلاليته كذات، وإسقاط جميع الخطوط الحمراء أمام حريته في التفكير والنقد والتعبير عن أفكاره، وآرائه، ورغباته، وميوله، طالما أنها لا تمس في شيء استقلال واستقلالية غيره.
بتعبير آخر ـ قد يكون أكثر وضوحا!ـ فلم تعد هناك حاجةٌ إلى أن يلبس شخصٌ ما لُبُوسَ “الفيلسوف” بما يعنيه ذلك من استعلاء على الآخرين (وبكل ما فيه من صلافة وقلة حياء أيضا!) بقدر ما يحتاج كل فرد إلى أن يصير فيلسوفَ نفسه، فينظر إلى واقعه وتاريخه بعيدا عن الأساطير، ويفكر في نفسه ـ على الشاكلة السقراطية ـ عوض التفكير في حصان مُجَنَّح أو في حمار خرافي يغني “الأطلال” ويطرب الناس.