القرآنُ عربيٌ لكنَّ العربية ليست قُرآنية. فالنص القرآني قد تَشَكَّلَ في القرن الميلادي السابع. أما العربية فهي تعود إلى عائلة “اللغات السامية” التي تشكلت قروناً قبل الميلاد. وسواء قبل ظهور الإسلام أو بعده فالمَتْنُ العربي لم يقتصر على النص القرآني وإنما تنوَّع بين الشعر والخطابة وسَجْعِ الكُهَّان والمقامات وباقي الأجناس الأدبية، مُروراً بالخطابات الأخرى، أي غير الأدبية، وانتهاءً بالمنطوق اليومي الذي حضرت فيه العربية ماضياً، وتحضر فيه حاضراً، ولا شك أنها ستظل حاضرة فيه مستقبلاً كذلك.
وإذا كان القرآن عربياً بقوة النص القرآني نفسِه (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) فلا شيء في القرآن يقول بأن العربية هي “لغة القرآن” على سبيل الحصر كما يزعم المتعصبون، ولا شيء يعطيها – بحكم ذلك – الأفضلية على باقي اللغات. وبالتَّبِعَة فلا شيء يعطي الأفضلية للعرب على غيرهم كما يتوهم بعض الشوڤينيين.
وحتى من الناحية الدينية الصرفة فإن مجيء القرآن بالعربية يرجع فقط إلى ظهور الإسلام أول مرة في بلاد العرب. وهذا أمرٌ واضح أيضا في القرآن نفسه: “وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم”. ولا ينطوي مجيء القرآن بالعربية على أي شيء أبعد من هذا، ولا يعطي أي أفضلية لها على باقي الألسن، ولا للعرب على باقي الأمم. فالقرآن ينص باللفظ الصريح على أن اللغات كُلَّها، وألوانَ الناس جميعاً، من آيات الله: “ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم”.
ولأن الله لا يبعث رسولاً إلا بلسان قومه فقد وَجَبَ بالقياس ألا يصل القرآنُ قوماً إلا بلسانهم. ولست هنا في حاجة إلى التذكير بأن “إلا” هي، في الآية أعلاه، أداةُ حصر، أي أن القرآن يجب أن يصل إلى كل شعب بلغته حصريا . وقد كان من المفروض في من يريد تبليغ القرآن أن يحمل القلم ليترجم الكتاب لا أن يحمل السيف ليقطع الرقاب. ومن ذات المنطلق فقد كان الواجب أن يصل القرآن إلى الأمازيغ بالأمازيغية فيتَّبعه من آمن به ويتركه من لم يؤمن به عملا بالمبدأ القرآني: “لا إكراه في الدين”. لكنَّ تعطُّش الأمويين إلى السلطة والنفوذ والتوسع، ونهب الخيرات، وسبي النساء، هو الذي جعلهم يبعثون السيف عوض القرآن المترجم إلى شمال إفريقيا.
بالطبع، يجب علينا أن نترك قضايا التاريخ للمشتغلين بالتاريخ وبالعلوم المختلفة التي تتدخل اليوم في صناعة المعرفة التاريخية. ولا يهمنا اليوم سوى تأكيد مبدأ بسيط للغاية وهو أن الإسلام لا يتماهى مع العربية ولا مع العرب، ولا يعني إبادة الحضارات المختلفة ولا استئصال اللغات التي يعتنقه الناطقون بها، أو بالأحرى جزءٌ من الناطقين بها. فالإسلام يصبح فارسيا في بلاد الفرس، ويصير تركياً في بلاد الأتراك، ويغدو صينياً في الصين، وهلم جرا. ويمكنه، بالنتيجة، أن يكون أمازيغياً في شمال إفريقيا. ذلك أن القرآن من آيات الله واختلافُ لغات البشر وألوانهم من آيات الله أيضا. ويمكن لآيات الله أن تنسجم مع بعضها، وأن تتفاعل في ما بينها، دونما حاجة إلى أي نزغٍ من نُزوغِ شياطين العنصرية والتطرف الأعمى. وحين يشهد شمالُ إفريقيا الهبَّة الهوياتية التي نشهدها منذ عقود فذلك لا يستهدف الإسلام في شيء ولا هو يروم القضاء على اللغة العربية، وإنما هو مسعى مشروع تماماً إلى استرجاع الهوية الأمازيغية التي حاول البعض ـ وما يزال يحاول ـ إبادتها باسم “العروبة” تارة، وباسم “الإسلام” تارة أخرى، وحتى باسم فكرة “أُممية” في بعض الآحيان.
ليست الأمازيغية أولاً محض لغة تتكلمها جماعة ما دون غيرها. فهناك عدد من الأمازيغ الذين لا يتكلمون الأمازيغية مثلما أن هناك ناطقين بالأمازيغية رغم أنهم ليسوا أمازيغ. وهي، ثانياً، ليست لغة بائدة أوميتة يريد البعض إحياءها. فهي موجودة، وحية، وتعيش في المنطوق اليومي لشعوب شمال إفريقيا. وهي ليست، ثالثاً، وعاءً لأي أيديولوجيا متعصبة، شوڤينية، تتوخى إعطاء الأفضلية لعرق على آخر لأن الأمازيغ ـ منذ أقدم العصور ـ لم يكونوا عرقاً واحداً. ومن هذا المنطلق فلا تصح أي مقارنة مع الأيديولوجيا النازية التي قام جوهرُها على فكرة سمو العرق الآري على باقي الأعراق. والتراث اليوناني القديم، بما فيه كتابات أفلاطون، يشهد على التواصل الذي ظل قائما بين سكان الشمال الإفريقي الأمازيغ من جهة واليونان القديم من جهة أخرى. وربما يكفي أن ديونيسوس هو في الأصل إله أمازيغي أخذه اليونان القدماء، وأن بوسيدون ليس سوى الإله الذي كان يعبده الليبيون كل يوم كما يقول هيرودوت، وأن اسم “ليبيا” نفسه مأخوذ عن إحدى إلهات اليونان القديم، وأن العديد من أبطال الميتولوجيا الإغريقية يرتبطون ببلاد المغرب، ومنهم العملاق “أطلس” الذي تحمل جبال الأطلس اسمه إإلى اليوم.
قطعاً، لا توجد في تاريخ المغرب القديم، ولا في تاريخ شمال إفريقيا برُمته، أي لحظة يمكن أن تشهد على أن الأمازيغ كانوا عنصريين أو منغلقين دون الحضارات والشعوب الأخرى. بل ربما كان تاريخُنا على العكس طافحاً بمظاهر الانفتاح، وزاخراً بتجليات التعايش والتسامح، سواء قبل مجيء الإسلام أو بعده. والأمازيغية ليست في حاجة إلى شهادة ممن كان بوقاً للقذافي، وصار بوقاً لإيران، ثم تَحَوَّل إلى “بْلاَيْغِي” لدى ذي المَعاشين، يركض أمامه في الممرات ليحمل “بَلْغَتَه” في مشهد تأباه، وتتبرأ منه، روحُ الأمازيغية والأمازيغ منذ أن خرج العلقُ من الطين وإلى يوم الدين.
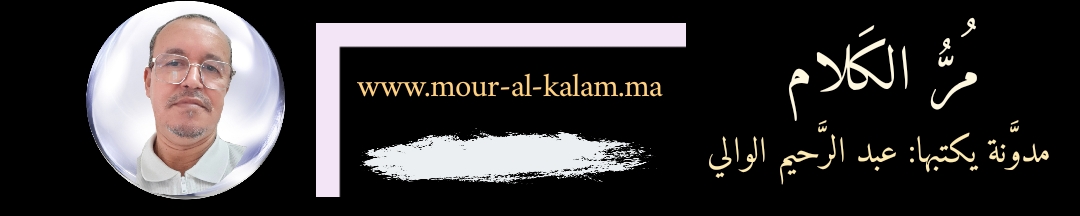
مرحبا أستاذ انا اقرأ مقالتي باستمرار و انتظرها بفارغ الشوق خصوصا التي تحفز العقل و تجبره على طرح اسئلة و البحث .
شكرا جزيلا لك