الدين في جوهره بسيط جدا. وهذه البساطة الجوهرية هي التي سمحت لباروخ سبينوزا بتأسيس مفهوم “الدين الشامل” الذي يتلخص في طاعة الله طاعة خالصة بممارسة العدل والإحسان. بمعنى آخر، فمفهوم “الدين الشامل” ليس مفهوماً تبسيطيا، ولا اختزالياً، وإنما حقيقةُ الدين أنه بسيط بالفعل وأن له، بالأساس، طابعاً عملياً تجسده قيمتا “العدل” و”الإحسان”.
تبدأ قيمة العدل من الذات وتتجلى في كيفية تعامل الفرد مع ذاته. ثم تمتد إلى التعاطي مع العالم الخارجي بما فيه وبمن فيه. وكذلك قيمة الإحسان. فهي لا تعني، كما قد يتبادر إلى أذهان البعض، صرفَ بعض الصدقات، أو الأُعطيات، لهذا أو ذاك ممن قد يحتاجونها، وإنما إحسانُك يبدأ من نفسك. ولربما كان أولُ مظاهر الإحسان إلى الذات إخراجُها من الجهل، والحرصُ على تثقيفها باستمرار، والعملُ على تزويدها بالمعارف النافعة. لكن هذا لا يعني بتاتاً أن الدين، في حد ذاته، يمثل نسقاً معرفياً بالمعنى الإبستيمي. فالدين يحث على المعرفة، وعلى السعي إلى تحصيلها، باعتبار ذلك ضمن باب الإحسان بالمعنى العام، دون أن يشكل هو ـ في حد ذاته ـ نظاماً معرفياً.
إن الدين لا يفسر الظواهر الطبيعية، ولا يقدم فهماً علمياً لها، ولا يشكل علماً عقلياً ولا يقدم حلاًّ لأبسط معادلة رياضية أو قضية منطقية. وحتى إذا ما عَرَّج النص الديني عامة، والنص القرآني بشكل خاص، على ظاهرة من ظواهر الطبيعة فهو يكتفي بوصفها، أو بوصف جانب منها، على سبيل الحِجَاج لا على سبيل التفسير العلمي. فهو مثلاً يتحدث عن المطر لكنه لا يقدم لنا القانون العلمي الذي يُمَكِّنُنا من صُنع المطر. وهو يصف تشكًّل الجنين في الرحم لكنه لا يذكر شيئا عن تركيبة الحيوانات المنوية، ولا عن تركيبة البُويضة، ولا ينبئنا نهائيا عن كيفية إحداث الإخصاب علمياً وتقنياً خارج الرحم. وقس على ذلك. فرهانُ الدين في جوهره رهانٌ عملي أخلاقي. ولذلك جاء الأمر صريحاً في الحديث النبوي: “إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارم الأخلاق”. ولم يقل إنه بُعِثَ لتقديم نظرية فيزيائية أو رياضية أولبناء نسق فلسفي أو حل معضلة منطقية.
غير أن فهم الأمر على هذا النحو يقود رأساً إلى إسقاط عُروش الكهنوت، والفقهاء، والشيوخ، وسائر المرتزقة الذين يعتاشون من الدين. ولذلك ابتكروا خرافة “الإعجاز العلمي” المزعوم، وسَخَّرُوا لها مختلف وسائل الترويج والدعاية، وتَسَمَّوا كذباً وبهتاناً ب “العلماء”، وأوهموا الناس أن هناك خلافاً وهُوَّةً بين الدين والعلم الحديث والمعاصر، بينما الواقع أن هذا الخلاف مستحيل لأنه لا يوجد أصلاً مجالٌ مشترك بين الدين والعلم يمكن أن يقع فيه الخلافُ بينهُما. فرهانُ العلم هو الطبيعة وظواهرها وقوانينها لمحاولة تفسيرها، والسيطرة عليها، والتحكم فيها، بغاية تقديم حلول للإنسان وبغرض الاستجابة حاجياته. أما رهانُ الدين فهو ـ كما أسلفنا ـ رهانٌ أخلاقي عملي يبتغي تحقيق قيمتين جامعتين كما بينهما سبينوزا، وهما قيمتا العدل والإحسان.
وفي حالة المسلمين، فعوض أن يكون الدينُ، بمعناه الأخلاقي العملي هذا، حافزاً على العمل الدؤوب وعلى الإخلاص والتفاني فيه، بما في ذلك في المجال العلمي، تحَوَّلت العقيدة إلى حاجز ذهني، ونفسي، وعقلي، بين المسلمين وعلوم العصر ومعارفه. ونجحت شرذمةٌ من فقهاء السوء وشيوخ ما بين الفخذين في تسويق الجهل والخرافة باعتبارهما “عِلْماً”، وفي إظهار العلم الحقيقي باعتباره “مؤامرة” على الدين. وكل ذلك حتى تحافظ هذه الشرذمة الضالَّة المُضِلَّة على امتيازاتها لدى الأنظمة الاستبدادية القائمة، هي الأخرى، على التجهيل والتضبيع. وعوض أن يُحْتَفَى بالكفاءات العلمية خصوصا، وبالكفاءات المعرفية والأدبية والإبداعية عامة، صار يُحتفى بالجَهَلُوت، وأضحى كلُّ من أنبت لحية، وارتدى قُفْطاناً أو جلباباً أو فُوقية، يسمي نفسه “شيخاً” أو “داعية” ويهدد الدولة والمجتمع بالحرب الأهلية وبقطع الرقاب. وبعد أن كان مغرب الحماية يشهد خلافات بين فقهاء بحجم أبي شعيب الدكالي ومحمد الحجوي الثعالبي أصبحنا نرى اليوم حفنة من الغلمان تتعالَمُ على الجميع.
بالتأكيد، فنحن نجني اليوم ثمار الانسياق وراء المد الوهابي والسلفي والإخواني وما شاكل ذلك حيث تحوَّل الدين، الذي هو في جوهره بسيطٌ كما تقدم، إلى سجل تجاري وأضحت “الدعوة” مهنة من لا مهنة له. ولنا أن نتصور، مثالاً لا حصراً، أي وضع كان سيكون فيه المدعو ياسين العمري، والمدعو “مول الفوقية”، والمدعو بنكيران، وغيرهم ممن يتقافزون اليوم، لولا أنَّ الدين تحول إلى تجارة وأن “الدعوة” المزعومة صارت حرفة. فأقصى ما كان سيحصل عليه أوفرُهم حظا أن يكون مُوظفا بسيطا. وكثيرٌ منهم ربما لن يحصلوا على وظائف حتى. لكنهم اليوم ينعمون بالأموال، وبما لذ وطاب، في بيئة تمَّ تحضيرُها طيلة عقود لتكون ملاذاً للجاهلين، ولتنظر إليهم على أنهم “دعاة” و”علماء” بينما العلماء الحقيقيون غادروا ويغادرون إلى غير رجعة.
هل تستوعب الدولة المغربية الدرس، وتدرك حجم الخطر المحدق بها وبالمجتمع، وتفكك وكر الثعالب؟ شخصيا، لستُ متفائلا. وأتصور أن الأسوأ ما يزال في انتظار أبنائنا وأحفادنا.
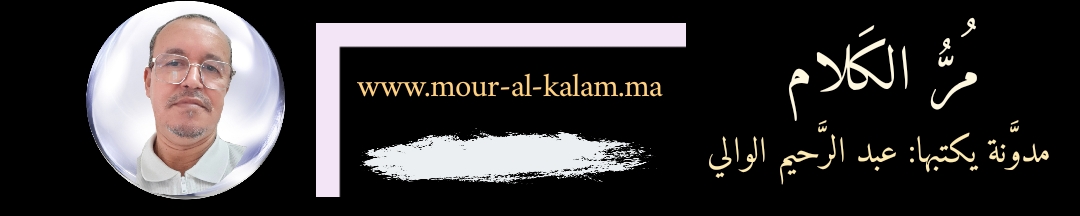
ربما يا استاذ نحن نعيش ارهاصات بداية عصر للانوار و هي اسرع مدة من نظيرتها في الغرب بسبب وفرة و سهولة الحصول الى المعلومة