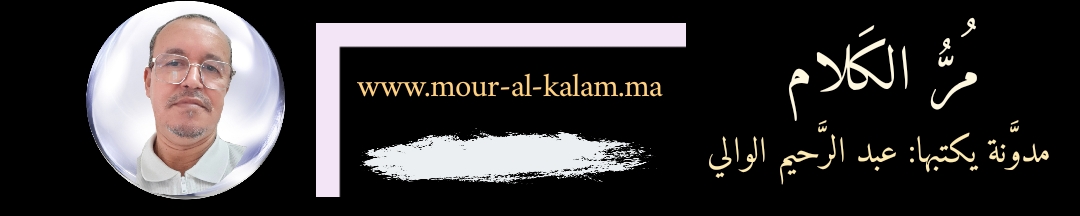جاء القرآن بدايةً في مجتمع صغير، ومحدود جدا، هو مجتمع مكة في مطلع القرن الميلادي السابع. وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً كان النبي يعرض القرآن، ومن خلاله يعرض الإسلام، سواء على أهل مكة أو على زوارها. وكان هؤلاء يتلقون منه القرآن ويفهمونه فمنهم مَن يُسْلِم ومنهم مَنْ يُعْرِض. وبعد الهجرة لبث النبي في المدينة عشر سنوات كان خلالها أيضا ينقُلُ القرآن إلى المسلمين وغير المسلمين. وكان الجميع يفهم القرآن سواء من يؤمن به أو مَن لا يؤمن به.
وبعد عصر النبوة ظل المسلمون وغير المسلمين يسمعون القرآن، أو يقرأونه، دون حاجة إلى أي وسيط. ولم يظهر التفسير، على الترتيب المعروف حاليا للقرآن، إلا مع ابن ماجة في أواخر القرن الثالث الهجري. وتفسيرُ ابن ماجة لا أثر له اليوم ويقال بأنه ضاع. والتفسير الذي يليه زمنيا هو تفسير الطبري. وهذا معناه أن أول كتاب في التفسير كما نعرفه اليوم قد ظهر في بدايات القرن الرابع الهجري، أي بعد ظهور الإسلام بما يقارب 323 سنة.
يبدو الأمر منطقيا ومفهوما تماما. فالخطاب القرآني لا يفترض أي وسيط بينه وبينه المتلقي. وهو يتوجه مباشرة إلى المُخاطب ويدعوه إلى تَمَثُّلِه، وفهمه، واستيعابه. وهو يتوقع من مُخَاطَبِه أن يَفْقَهَهُ، أي أن يفهمه، مباشرة ودون أي وسيط، وأن يتجاوب معه أيضا باعتباره خطاباً وجدانيا موجها إلى القلب. والآيات التي تنص على ذلك بشكل صريح أكثرُ بكثير من أن نثبتها هنا جميعا. ويمكن لمن أراد أن يعود إليها مباشرة في النص القرآني.
لكنْ، مع استمرار الغزو الإسلامي للأقطار المجاورة لشبه جزيرة العرب ـ بعد زمن النبوة ـ اتسعت حدود الدولة. ولم يعد القرآن، كما كان بادئ الأمر، حبيس مجتمع مكة الصغير، ولا هو صار محدودا في بلاد العرب، وإنما تخطى ذلك إلى رقعة جغرافية امتدت في العهد الأموي من بلاد فارس إلى شمال إفريقيا والأندلس. وبالنتيجة فلم يعد مُخَاطبُ القرآن محصورا في المتلقي العربي. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الوسيط. وهي المهمة التي كان من اليسير جدا أن تقوم بها الترجمة، وكان من الممكن بالتالي أن يُخْتَزَلَ دورُ الوسيط في المُترجم. لكن الشوفينية العربية، عوض ترجمة القرآن إلى لغات الشعوب الأخرى، التي دخلت الإسلام أو أْدْخِلَت إليه بحد السيف وتحت ترهيب الجزية، فَرَضَت اللغة العربية على تلك الشعوب. ومن هنا برزت الحاجة إلى المُفَسِّر وإلى كتاب يُفسِّر القرآن وفق ترتيب المصحف العثماني. فقد صارت اللغة حاجزا أمام الفهم بعد أن كانت، في زمن الإسلام الأول، طَيِّعَةً بالنسبة لذوي اللسان العربي. وكان من المنطقي جدا أن يكون أول المفسرين الذين نجد كتبهم اليوم هو الطبري الذي، حتى وإن عاد البعض بنسبه إلى اليمن، فهو قد ولد في طبرستان التي كانت آنذاك جزءً من بلاد فارس، وتوجد اليوم داخل حدود تركمنستان. وربما يكون الطبري نفسُه فارسياً أوتركمانياً. وهذا موضوع آخر قد نتوسع فيه مستقبلاً.
الحاجةُ إلى الوسيط لم تقف طبعاً عند الحاجة إلى التفسير والمُفَسِّر، وإنما صارت هناك حاجةٌ أيضا إلى استخراج أحكام للقضايا التي استجدت في القرون الموالية لزمن النبوة. أضف إلى ذلك الجدال المحتدم بين طوائف المسلمين وفِرَقِهِم الكلامية، والصراع الدائر حول السلطة السياسية والذي بدأ منذ سقيفة بني ساعدة، ناهيك عن الاحتكاك مع أهل المِلَل الأخرى، وما إلى ذلك. فبفعل هذه العوامل كلها، وغيرها، صارت هناك حاجة ملحة لدى الحكام إلى وظيفة “الفقيه”. وتَشَكَّل بحُكم ذلك حول دوائر الحكم جسمٌ فُقَهائي غارقٌ في الانتهازية الرخيصة، حارَبَ الفلسفة، بل وحارب حتى علم الكلام الإسلامي نفسَه، وخَدَم المشروع الاستبدادي بكل ما يملك من قدرة رهيبة على تسويغ القهر والبطش والاضطهاد. وقد تجلى الإحساس بهذا الدور القَذِر للفقهاء في تلك الصرخة الشعرية التي أطلقها ابن سارة الشنتريني في وجوههم حين قال في قصيدته الشهيرة:
يا ذِئَاباً بَدَتْ لنا”
في ثياب مُلَوَّنَه
أَحَلالاً رأيتُمُ
أَكْلَنا في المُدوَّنَه؟ “
وقد كان يقصد، بالطبع، مدونة الإمام مالك الفقهية. وهو ليس الشاعر الوحيد الذي فضح قذارة الفقهاء على كل حال.
وبينما كان الفقهاء يُفتُون للأمراء، والخلفاء، والملوك، بما يريدون من قتل المعارضين وقهر العوام وما إلى ذلك كانت قصور هؤلاء تمتلئ بالغلمان، وينتشر في مجالسهم الغَزَلُ بالمُذكَّر، وتُمَارَسُ بين أيديهم ومن طرفهم أبشع أشكال الاستغلال الجنسي لأولئك المُستعبدين دون أن يجرؤ الفقهاء على الكلام. بل كان من هؤلاء الفقهاء شاعرُ الغلمانيات والخمريات الأكبر والأشهر، الحسن بن هانئ، الملقب بأبي نواس، والذي طالما قيل عنه إنه “فقيه غلب عليه الشعر”. والأصح أنه كان فقيها وكفى. وإذا كان قد غلب عليه بالفعل شيء ما فقد غَلَبَ عليه ما غَلَبَ على سائر الفقهاء: القربُ من السلطان، ونكاحُ الغِلْمَان، ومقارعةُ الدِّنَان.
وكما تناسل الفقهاء والمفسرون تناسلت الزوايا والشيوخ، وصار لكل شيخ مريدون بمُلْتَحِيهم وأَمْرَدِهِم، ومثلما انتشرت “الغلمانيات” داخل قصور الخلفاء انتشرت في الزوايا حتى كان الإمام عبد الوهاب الشعراني مضطرا إلى أن يُفرد لذلك حيزا في رسالة “الأنوار القدسية”.
وسواء تعلق الأمر بالشيوخ، أو بالفقهاء، أو بالمفسرين، فالكل كان يكتسب السطوة والحظوة من السطو على النص القرآني، ومَنْعِ الناس من استخدام عقولهم وأفهامهم في التعاطي معه، بدعوى أنه نص مستغلق لا يمكن فهمه إلا من طرفهم، وبناء على أدواتهم “المعرفية” المزعومة. والواقع أن النص القرآني جاء ب”لسان عربي مُبين” وتُعتبر الإبانة من خصائصه: “هذا بيانٌ للناس وهدى وموعظة للمتقين”.
نعم! إنه “بَيَانٌ للناس” وليس طلاسم لا يفهمها إلا “الفقيه” أو “المفسر” أو “الشيخ”. وقد آن الأوان لاسترداد القرآن من لصوص القرآن، أي من سطوة “الفقيه” و”المفسر” و”الشيخ” وغيرهم من الذين حولوا النص القرآني، والدين عامة، إلى سجل تجاري وإلى وسيلة لترهيب المجتمع والأفراد حفاظا على مصالحهم وسعياً إلى تحقيق المزيد.