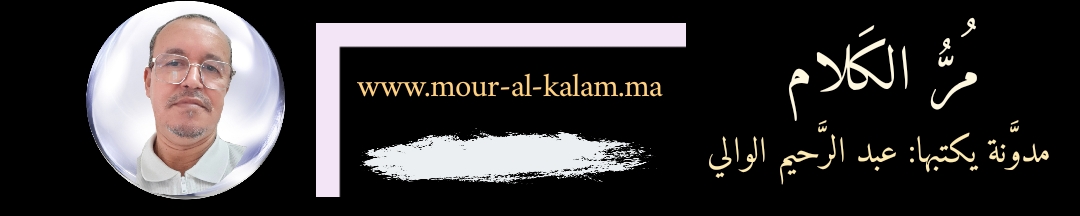ليس القرآن ـ خلافاً للوهم السائد ـ كتاباً للمسلمين. والخطاب القرآني، خلافاً للوهم السائد أيضا، ليس موجها للمسلمين دون غيرهم. بل إن القرآن مُوَجَّهٌ بالأساس لغير المسلمين، وغايتُه الأولى واالأخيرة هي دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. بمعنى آخر، فهو في المقام الأول كتابُ دعوة.
ولكي ينجح في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فقد وَجَبَ أن يكون خطابُه، أولاً، خطاباً واضحاً، بَيِّناً، ومفهوماً. وذلك حتى يتسنى لمن يسمعه أو يقرأه أن يفهمه. والقرآن لا يتوقع من سامعه أو قارئه، مبدئياً، غير ذلك. فهو يدعوه إلى فِقْهِهِ، أي إلى فهمه، وإلى تدبُّره من طريقين رئيسين: العقل والقلب. لكنه يُرَجِّحُ الثاني على الأول في عدد من المواضع. وفي كثير من الآيات يرتبط الفقه، أي الفهم، بالقلب باعتبار الخطاب القرآني خطاباً وجدانياً. وكذلك التدبُّر نجده مرتبطا بالقلب، أي بالوجدان. وإذا كان لا بد من الاستشهاد ببعض الآيات فيكفي أن نذكر الآية التي تقول “إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد”، وإلى جانبها الآية التي تقول “أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالُها”. فالمعنى في الآيتين واضح، جلي، يكاد لا يحتاج شرحا ولا تفسيرا. لكنْ، لا بأس مع ذلك من توضيحٍ أكثر لما أحاول أن أبينه هنا.
لو افترضنا أن شخصا ما يلقي على مسامعنا محاضرة في قضايا منطقية معقدة فهو، بالتأكيد، لن يطلب منا الاستماع إلى محاضرته بقلوبنا. فالخطاب العقلي المعقد، الجاف، مثل خطاب الرياضيات والمنطق وباقي العلوم يتوجه إلى العقل لا إلى القلب. أما الخطاب الذي ينفذ إلى القلب، أي إلى الوجدان، فهو الخطاب الذي لا تعقيد فيه. وهو في الغالب خطابٌ يعتمد على الاستمالة وعلى وقع الصوت من النفس وفيها. وإلى ذلك يشير الجاحظ في كتاب “الحيوان” حينما يذكر واقعة بكاء مَاسَرْجَوَيْه من سماع القرآن. فقد قيل له : “كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ فقال: إنما أبكاني الشَّجا”. (الكلمة تكتب عادة بالألف المقصورة لكن الجاحظ كتبها ممدودة. ولا يسعني أن أدعي المعرفة بالعربية أكثر من الجاحظ).
نعم، غاية القرآن هي الدعوة إلى الإيمان الديني. والإيمان الديني ـ مهما حاول الناس عقلنته ـ يظل في البداية والنهاية أمرا وجدانيا وحاجة وجدانية أيضا. وهذه الغاية لا يحققها الخطاب المُجرَّد، المعقَّد، الذي يتغَيَّى العقل والاستدلال بقدر ما ينالُها الخطابُ السَّلِسُ الذي يتوخى القَلبَ ويرومُ إحداث الأثر وإثارة الانفعال. وفي هذه العلاقة الوجدانية مع الخطاب القرآني يلعب فهمُ المعنى، والإحساسُ به وجدانياً، الدور الحاسم. وهي علاقة تقتضي أن يكون المعنى واضحاً ومؤثرا، لا أن يكون مُسْتَغْلقاً، ممتنعاً، لا ينالُه عقلُ السامع فأحرى أن يدركَه قلبُه. ولذلك ارتبط الفقه في الخطاب القرآني بالقلب (لهم قلوبٌ لا يفقهون بها). بل إن العقل نفسه ارتبط بالقلب باعتباره هو الآخر، في معناه القرآني، عملية وجدانية (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها). فالعقل المطلوب في القرآن، والفقه المطلوب في القرآن، لا ينفصلان عن القلب وهما عمليتان وجدانيتان بالأساس يُفْتَرَضُ فيهما أنهما تقودان كل مَنْ يستمع للقرآن، وينصت إليه، إلى الإيمان به. بمعنى آخر، فإن فقيه القرآن هو القلب، أي أن فقيه كُلِّ امرئ قلبُه في إطار علاقة إيمانية، وجدانية، روحية، فردية، مباشرة، مع الخطاب القرآني.
ليس الخطابُ القرآني إذن خطابا غامضا، عويصا، مستعصيا على الفهم، كما يزعم الذين أسميتُهم في مقال سابق ب”لصوص القرآن”. بل هو خطابٌ جاء يسيرا، واضحا، من حيث هو خطابُ دعوة إيمانية. ولا يُتصور أن شخصا غير مسلم يسمع القرآن ولا يفهمه، ثم يذهب إلى فقيه يشرحه له، ويبين له أحكامه، لكي يؤمن به. ولا أعرف في ما قرأت وسمعت حتى الآن شخصا واحدا أسلم على يد فقيه أو بعد قراءة كتاب في الفقه الإسلامي. لكن عدد الذين أسلموا تحت التأثير الوجداني لقراءة القرآن أكثرُ من أن يُحصَرَ هنا.
وعلى ما يبدو فوظيفةُ الفقيه لا أصل لها في القرآن وإنما هي وظيفة سياسية أحدثها الحكام لخدمة سياساتهم، وأحدثتها الفرق والجماعات المعارضة المتطلعة بدورها إلى الحكم، وحَوَّلَها الكسالى، وذوو الأذرع المكسورة، إلى وسيلة للتكسُّب والارتزاق لدى الحكام ولدى زعماء الفرق والجماعات وغيرهم. فهي، بالمعنى الديني، بدعَة اقتضتها الحاجة السياسية إلى الفتوى والتشريع. ذلك أن الحاكم كان في حاجة إلى فتاوى وتشريعات تحوِّلُ طاعته إلى واجب شرعي وتجعل الخروج عليه “زندقة” و”مُروقاً من الدين”، مثلما كان زعيم الطائفة والفرقة المعارضة، الساعية هي الأخرى إلى الحكم، في حاجةهو الآخر إلى فتاوى توجِبُ طاعتَه على الأتباع والمُريدين، وتُبيح له دم الحاكم ومُلْكَه. ولذلك كان الفقه الفُقَهَائي مجالا سياسيا أكثر منه مجالا دينيا وغَلَبَ عليه الطابعُ التشريعي خلافاً لمعنى الفقه في القرآن، والذي يبقى ـ كما أسلفنا ـ علاقة عاطفية، وجدانية، قلبية، روحية، مع النص القرآني ومن خلاله مع مصدر النص ذاته إيمانياً: الله. وفي المسافة الفاصلة بين الفقه القرآني والفقه الفُقَهَائي تشكلت عصابات ممن سموا أنفسهم – ولم يُسَمِّهِم أحد – ب”الفقهاء” وحولوا القرآن والإسلام إلى محمية يستأثرون بها دون العالمين.