أديبٌ فرنسي شهير هو هكتور مالو. وروايةٌ شهيرة لنفس الأديب هي رواية “دُونَ عائلة”. وفي تلك الرواية ينجح المهرج فيتاليس في تعليم قرد وثلاثة كلاب كيفية القيام بأدوار مسرحية. ثم يشتري بعد ذلك طفلا، هو بطل الرواية، ويبدأ في تعليمه أيضا كيفية القيام بنفس الشيء، أي لعب أدوار مسرحية. وأثناء تعليمه يشرح له كيف نجح في جعل الحيوانات التي يمتلكها تكتسب المهارات التي صارت لديها. ويلخص منهجه في عدم تخويف تلك الحيوانات قائلا: “الخوف يشُلُّ الذكاء”.
لماذا أستعيد الآن هذه الرواية؟ ولماذا أستعيد، بالضبط، جملة هكتور مالو هذه على لسان أحد شخوص الرواية؟
لعل الجواب الأقرب إلى الواقع هو أنني، على غرار الملايين من أمثالي، قد نشأت وتعلمت في نظام تربوي قائم على التخويف. ولم يكن النظام التربوي إلا جزء من نظام أكبر ـ هو النظام السياسي ـ قائمٍ بدوره على نفس الدعامة: التخويف. فقد كنا نخاف من عصا المُعَلِّم كما نخاف من عصا الشرطي. ولم يكن الخوف يقف عند باب المدرسة، أو عند بوابة الكوميسارية، وإنما كان يتخطى عتبة البيت. فكان يتملكنا الرعب أيضا من عصا الأب أو الأم. لقد كنا في ما صار يُعْرَفُ لاحقاً ب”سنوات الرصاص” حيث كان الخوف يطل برأسه من كل مكان. ولذلك أتصور أننا جيلٌ نشأ مشلولَ الذكاء رغم أننا صرنا نُوصَفُ اليوم ب”الجيل الذهبي”.
غير أن الخوف الذي كان يسكننا ـ وربما لا يزال! ـ ليس (ولم يكن!) معزولاً تاريخياً ولا جغرافياً. فنحن ننتمي جغرافياً إلى فضاء يدعى “العالم العربي الإسلامي”. وهو الفضاء الذي ظل يحكمه الخوف وما يزال حتى وإن حدثت بعضُ الانفراجات كما هو الشأن في المغرب اليوم. ونحن ننتمي تاريخياً إلى سيرورة تطفح بالمجازر، والإبادات، والتعذيب، وكل ما يبعث الرعب في النفوس. ولربما لم يكن من محض الصُّدَف أن تكون أشهر ساحة في بلدنا هي ساحة “جامع الفنا” بمراكش. و”الفْنَا” في اللسان المغربي الدارج لا يعني سوى “الفَنَاء”. وهو الاسم الذي اكتسبته الساحة المذكورة من مشهد الرؤوس المقطوعة التي كانت تُعَلَّقُ على أسوارها في سالف الزمن المغربي حسب الرواية المتداولة.
بالطبع، فقد كانت الغاية من تعليق الجماجم على أسوار مراكش هي بث الرعب في نفوس الذين كانت رؤوسهم لا تزال فوق أكتافهم. لكن مراكش لم تكن لتنفرد وحدها بهذا التاريخ المُخَضَّب بالدم. بل إن الدم يكاد يكون موزَّعاً بالقسطاس المستقيم على تاريخ “العالم العربي الإسلامي” برُمَّتِه. ولم تسلم من ذلك حتى أكثرُ الأماكن قدسيةً لدى المسلمين. فقد أريق الدم في الحرم المكي نفسه، وقُطِعَت رؤوس الصحابة، وتسللت خناجر الغدر إلى الخلفاء الراشدين، بل وسال دمُ النبي نَفسه في غزوة أُحُد، وقُذِفَ بالحجارة في الطائف، وركض حافياً حتى دَمِيَتْ قَدَمَاه.
وعلى امتداد تاريخ الإسلام ظلت تهمة “الزندقة” و”الإلحاد” سيفاً مسلطا على رقاب كل مَنْ سولت له نفسُه الخروج عن القطيع. وبالتهمة نفسها تم التنكيل بالفارابي، وابن رشد، والحسن بن الهيثم، وغيرهم كثير. وكان للفقهاء طيلة هذا التاريخ الدموي القسطُ الأوفر في شرعنة القمع، والترهيب، واغتيال العقل، وإشاعة الظلام، ونشر الخرافة والدجل. والنتيجة هي أننا كشعوب كنا دائما، وما نزال، داخل جغرافيا الخوف، وداخل تاريخ الخوف، وداخل ثقافة الخوف. فنحن شعوب مشلولة الذكاء، لا تتعلَّم، ولا يمكنها أن تتعلَّم.
ولربما كان من سوء حظنا تاريخيا أن الحدث الذي كان مدخلاً إلى تحرير الإنسان في الغرب كان هو عينُه الذي كرَّس شَللَنا لأكثر من ستة قرون في العصر الحديث. وأعني هنا سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين سنة 1453. فهذا الحدث يُعتبر، من الناحية التاريخية، هو الفيصل بين العصر الوسيط والأزمنة الحديثة في الغرب. وابتداء منه دخل الإنسان في أوروبا خصوصا، وبعد ذلك في الغرب عامة، عصر التحرر من سلطة الخوف الذي كانت تمثله الكنيسة والحكام. لكنَّ الحدث إياه، بالمقابل، كرَّس قوة النظام العثماني في “العالم العربي والإسلامي” كنظام استبدادي، ظلامي، متخلف، قائم على الخوف الذي يشل الذكاء. والنتيجة هي أن الغرب الذي تحرر من الخوف، ابتداء من تلك اللحظة التاريخية، قد ظل يتقدم طيلة ما يزيد عن ستمائة عام في سائر المجالات، بينما غرق “العالم العربي والإسلامي” في التخلف تحت الحكم العثماني. وحتى إذا كان المغرب قد ظل خارج سلطة العثمانيين فإنه لم يكن خارج هذا السياق الثقافي والسياسي العام، وغرق هو الآخر في ظلمات الجهل المُتَعالِم.
واليوم، بعد قرن وسنة واحدة على سقوط آخر قلاع الاستبداد العثماني (1923) ما يزال ذكاؤنا مشلولاً، وما يزال صُنَّاعُ الخوف يشتغلون بحماسة نادرة على إبقائه كذلك. وهم يبدعون في صناعتهم تلك أيَّما إبداع من الحكام الذين يقتنون آخر أليات ومعدات القمع والبطش والرعب الموجهة لصدور وجماجم الشعوب، إلى “الشيوخ” الذين يبدعون في وصف الثعبان الأقرع!
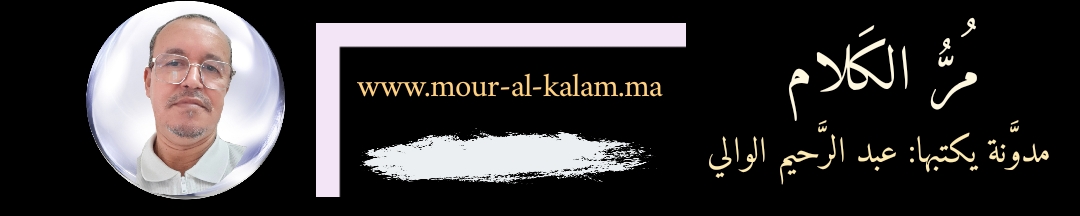
تحليل جيد لمنابع الخوف في مجتمعاتنا المسماة عربية إسلامية، و قد أضيف أن القمع و محاربة الحرية أصبحا متغلغلان في بنية المجتمع الفكرية و العقائدية و أصبح الناس في مجتمعنا يدافعان عن القمع و يقفون سدا منيعا شرسا ضد كل من ينادي بالحرية أو فقط يشير إليها.