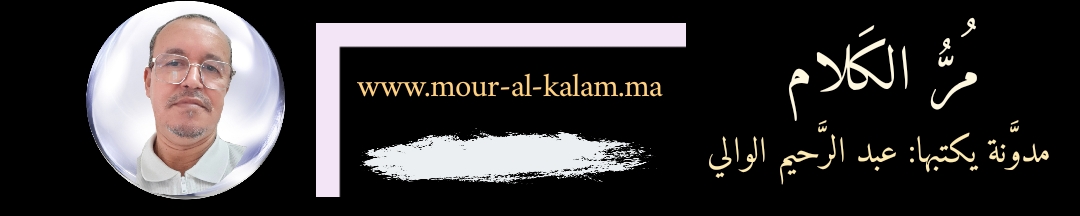لا أعرف سمية. ولم يسبق لي أن التقيتُ بها. والراجح أننا لن نلتقي أبدا. وقد كان كل ذنبي في ذلك اليوم أنني، كالعادة، ركبتُ سيارة الأجرة لكي أذهب إلى عملي.
داخل السيارة وجدتُ نفسي بجانب امرأة تضع ـ مثلي تماما ـ نظارة طبية. كانت تمسك بين يديها هاتفا ذكيا. وما كادت السيارة تتحرك حتى قامت بتشغيل مكبر الصوت واتصلت بشخص ما. وبعد بضع رنات أجاب من الجانب الآخر صوتٌ نسوي مبحوح. وكان عليَّ وعلى جميع الركاب أن نعرف قصة سمية بنت “أ” التي ـ حسب المكالمة ـ وُلدت منذ أيام فقط، واكتشفت أمها أنها وُلدت بدون مَخْرَج خلفي. ولم أعرف تفاصيل القصة بالكامل، ولا نهايتها، لأنني كنت قد وصلتُ إلى النقطة التي أنزل عندها عادة، بجوار الثانوية التي أعمل بها، بينما القصة كانت لا تزال مستمرة عبر مكبر الصوت. وكان موضوعها طبعا هو العملية الجراحية التي أجريت لسُمَيَّة بنت “أ” من أجل فتح مَخْرَجٍ خلفي لها.
بعد أن غادرتُ سيارة الأجرة استحضرتُ شريطا كان قد بعث إلي به أحد الاصدقاء. وهو شريطٌ قامت سائحة غربية بتصويره على متن قطار في أوساكا اليابانية. كان القطار ممتلئا عن آخره بالركاب جالسين وواقفين. ولكنَّ الصمت وحده كان يُسْمَع داخله إن جاز أن نقول إن للصمت صوتاً يمكن أن نسمعه. لا أحد يتكلم على الإطلاق. وكان ذلك الصمت الياباني، بالضبط، هو ما أثار السائحة الغربية وجعلها تصورالشريط. وبعد أيام من مشاهدتي لهذا الشريط كنت على موعد مع شريط آخر يتوجه فيه اليابانيون إلى عملهم صباحاً. وهذه المرة كانوا يسيرون على الأقدام. وكان الصمتُ مرة أخرى سيد الزمان والمكان.
لم يكن الشريطان أول مرة ألتقي فيها مع هذا السلوك الياباني. ففي سنة 1995 كنت في بداية مشواري كصحافي مهني. وكان علي أن أذهب بمعية مصور الجريدة لتغطية وصول سفينة السلام اليابانية إلى ميناء الدار البيضاء، والتي كان في استقبالها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان آنذاك، عبد العزيز بناني، ونائبه إدريس بنزكري إلى جانب فعاليات حقوقية أخرى. وكان أول ما أثارني في ذلك الصباح هو أن اليابانيين لم يكونوا ثرثارين. وبعد مراسيم الاستقبال في الميناء كان مقررا أن ينظموا معرضا عن مأساة هيروشيما وناكازاكي، وأن يقيموا ندوة صحفية، في المركب الثقافي سيدي بليوط. وما أن وصلنا إلى هناك حتى انتشر اليابانيون في بهو المركب، بخفة ونظام، ودون كلام كثير، ونصبوا مجموعة من اللوحات في أرجاء البهو، ثم وضعوا في الوسط طاولة صغيرة وشغلوا الميكروفونات، وانطلقت الندوة الصحفية والمعرض في موعدهما المقرر وفي نفس الوقت. وما أن انتهت الندوة حتى قاموا بتفكيك كل شيء، بسرعة البرق، وعادوا إلى الميناء ليواصلوا رحلتهم عبر العالم من أجل نشر رسالة السلام.
لقد مضوا دون أن نعرف حتى أسماءهم. وفي اليوم الموالي، أثناء اجتماع هيئة التحرير، سألني مدير الجريدة آنذاك، الراحل علي يعته، إن كنت قد تمكنت من إجراء حوار مع مسؤولي “سفينة السلام” فحكيت له كيف أنهم جميعا قد تبخروا قبل أن يتمكن أي صحافي من اقتناص فرصة للحوار معهم، وأن كل ما تمكنت منه هو التقاط تصريح قصير مع أحدهم. وما كان منه إلا أن ضحك وهو يقارن بينهم وبيننا في ما يخص تدبير الوقت. وقد كان حينها يقطر الشمع على أحد الزملاء الذي كان ما يزال يعاني من آثار النوم وهو داخل الاجتماع.
واليوم، بعد تسعة وعشرين عاما، أجد نفسي مضطرا إلى المقارنة بيننا وبينهم على صعيد السلوك الحضري. فبين الصمت الياباني في القطار والأخت “الحَكَواتية” في سيارة الأجرة التي كنت أركبُها يمتد فارق حضاري قد يصل، زمنيا، إلى عدة قرون. وليست تلك “الحكواتية” حالة معزولة بالطبع. فعادة تشغيل الهواتف بمكبرات الصوت، سواء في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العمومية، صارت متفشية بشكل لم يعد مقبولا. ولم يعد من النادر أن تجد نفسك عرضة لهجوم شامل بأغاني الواي واي، وباقي أشكال النهيق، وأنت تشرب قهوتك. كما لم يعد من النادر أن تجد نفسك تعرف ـ رغماً عن أنفك وعن أنف أبيك ـ سمية بنت “أ” وقصة شَقِّ مَخرَجِها الخلفي. وأكاد أجزم بأن فرناند دي ليسيبس، وهو يشق قناة السويس، لم يتحدث عنها مثلما تحدثت تلك المرأة عن شق مَخْرَج سمية بنت “أ”.
أثناء انعقاد المؤتمر التاسع عشر لاتحاد الكتاب العرب كنت أحاور الشاعر المصري، عبد المنعم رمضان، فقال لي بأن أدوات الحداثة حين تأتي إلى أوطاننا تتغير بعض وظائفها. وكان يقصد أن الناس يسستعملون تلك الأدوات في غير ما خُصِّصَت له مثلما كان بعض المغاربة ـ إلى حدود السبعينيات ـ يستعملون أسطوانات التسجيل في علاج “النار الفارسية”. ولكنْ، لا أحد منا آنذاك توقع ما يمكن أن يحدث حين ستصل الهواتف الذكية إلى أيدي الأغبياء. ولا أحد كان يتوقع أن تصبح مؤخرات الصبيان الأبرياء منتوجاً “إعلامياً” داخل سيارات الأجرة. ولعل لله في ذلك حكمة لا ندركُها.