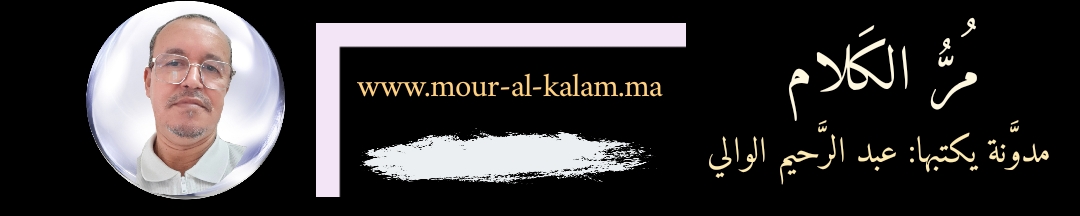قد لا يعرف كثيرٌ من الناس أن اليونان القديم كان أقرب إلى بلاد المغرب، جغرافياُ، من اليونان الحالي. ولا يتعلق الأمر هنا بأي تحول جيولوجي كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فاليونان القديم كان إِذَّاك حيث يوجد اليونان المعاصر اليوم. لكن اليونانيين القدماء كانوا قد أسسوا، في حوالي سنة 600 قبل الميلاد، مدينة يونانية هي مدينة « ماساليا » أو « ماسيليا » والتي ليست سوى مدينة مارسيليا الفرنسية كما نعرفها اليوم.
حضارةُ هذه المدينة اليونانية القديمة امتد نفوذها وتجارتها ومختلف مبادلاتها إلى الجنوب الإسباني. وبمعنى آخر، فإن الحضارة اليونانية القديمة كانت على مشارف الشمال المغربي. وعندما نتحدث عن القرن السادس قبل الميلاد، بالنسبة للتاريخ اليوناني القديم، فنحن بصدد الفترة التي اكتمل فيها ذلك التحول الذي كان قد انطلق قبل قرنين من ذلك التاريخ، أي منذ القرن الثامن قبل الميلاد، والذي قاد إلى ظهور الفلسفة.
ولعل هذا القرب الجغرافي بين الحضارة اليونانية القديمة من جهة وبلاد المغرب من جهة ثانية هو الذي يفسر حضور عدد من الرموز المغربية في الميتولوجيا اليونانية أولاً، مثل العملاق أطلس، والثمرة الذهبية التي جاء بها أخيل من بلاد المغرب، والإله ديونيسوس. كما أنه يفسر ثانياً حضور حضارة أطلنتيس في كتابات أفلاطون. وهي الحضارة التي ظل يُعتَقَدُ أنها كانت مجرد منتوج للخيال الأفلاطوني، قبل أن تكشف معطيات الأقمار الاصطناعية المتطورة، وكذا بعض الدراسات المتخصصة، آثارها في جنوب المغرب وموريتانيا الحالية.
هذه المعطيات البسيطة التي نتحدث عنها هنا والآن لا تشكل بالنسبة للمختصين في البحث التاريخي أي جديد على الإطلاق. فهي بالنسبة لهم معروفة ولا تمثل سوى جزء ضئيل جدا من الاكتشافات التي انتهت إليها الأركيولوجيا وباقي العلوم التي تتقاطع مع مجال المعرفة التاريخية. غير أن المعطيات إياها تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة لكاتب رأي من مستوى متواضع مثلي. وربما هي تكتسي نفس القدر من الأهمية بالنسبة للقارئ الذي يجود على هذا الكاتب، ذي المستوى المتواضع جدا، ببعض الدقائق من وقته لقراءة هذه الخربشات.
ولربما كان أول مظهر من مظاهر أهمية هذه المعطيات هو أن المغاربة في القرن السادس قبل الميلاد كانت لهم مبادلات ثقافية مع الحضارة اليونانية القديمة، وأن رموزا ثقافية مغربية قد وجدت مكانها في الميتولوجيا اليونانية القديمة. وبالاقتصار على العملاق «أطلس» الذي تقدم ذكره فلا أحد يمكنه أن ينكر أن الاسم أمازيغي معنىً ومبنىً. كما أننا إذ نتحدث عن القرن السادس قبل الميلاد نكون قبل ثلاثة عشر قرناً من ظهور الإسلام وانتشار العربية، بفعل الدين الجديد، خارج شبه جزيرة العرب. أضف إلى ذلك أن ما تقدم معناه أن المغاربة كانوا دائما جزءً لا يتجزأ من الحضارات المتوسطية التي شكلت عبر التاريخ تلك النواة التي قامت عليها الحضارة الغربية التي تسود عالم اليوم، وتتسيَّدُه، أحبَّ مَنْ أحبَّ وكره مَن كره. ولا يمكن اليوم لأحد أن يختزل المغرب والمغاربة في رافد ثقافي واحد هو الرافد العربي الإسلامي الذي لم يدخل بلاد المغرب إلا في القرن السابع الميلادي، ولم يترسخ فيها إلا بعد قرون أخرى.
ليس صدفة أن أقدم إنسان عاقل عُثر عليه حتى الآن هو إنسان جبل إيغود في المغرب. ومن نافل القول التذكير بأن الإنسان العاقل كان إنسانا ناطقا، أي أنه إنسان كانت لديه اللغة. فالعلم يؤكد اليوم أن إنسان الكهوف نفسه (النينديرتال) كانت لديه اللغة. وهو ما تشهد عليه الأدوات التي خلَّفَها والتي صنع كثيرا منها بناء على فكرة التماثل، علماً أن الباحة الدماغية المسؤولة عن التماثل هي عينُها المسؤولة عن اللغة. ومع أن لغة إنسان جبل إيغود قد لا تكون هي الأمازيغية فإنها، في الآن نفسه، ليست العربية. وتسهيلا للمأمورية سوف أسمح لنفسي بأن أسميها «الإيغودية» توخياً للاختصار في التعبير.
لعل الإيغودية تكون واحدة من أسلاف الأمازيغية أوحتى من أسلاف اليونانية أو اللاتينية. ففي الزمن الإيغودي لم تكن هناك حدود ولا تأشيرات تمنع انتقال الناس في أرض الله الواسعة. ولا شيء يمنع من أن يكون أولئك الإيغوديون قد تكلموا لغة ربما لا فكرة لنا عنها اليوم على الإطلاق. لكن الأكيد هو أنهم كانوا واحدا من الشعوب المتوسطية وأن لساناُ ما، أو ربما ألسنةً، من ألسنة شعوب المتوسط مشتق(ة) من لسانهم. ومن المؤكد أنهم لم يكونوا ناطقين بالعربية تماما مثل خَلَفِهِم الذي عاصر حضارة ماسيليا في القرن السادس قبل الميلاد.
ما الذي حصل طيلة ذلك الزمن الممتد من إنسان جبل إيغود إلى زمن حضارة ماسيليا؟ وما الذي جرى منذ حضارة ماسيليا إلى زحف جيوش كاليغولا على بلاد المغرب؟
لا أحد يعرف التفاصيل. لكن الثابت هو أن إرثاً حضارياً عظيماً قد تعرض للمحو والإبادة والطمس. والشاهد الأبرز عليه اليوم هو الزي الأمازيغي والحلي الأمازيغية والمفروشات الأمازيغية بجماليتها الباهرة، والموسيقى الأمازيغية بمقامها الخماسي وإيقاعاتها الغنية والمتنوعة، وما تبقى من نقوش أمازيغية على الصخور. فلا يوجد شعب ينقش أبجديته على الحلي والمفروشات دون أن يكون شعباً ساكناً متحضرا. ذلك أن صناعة الحلي تستوجب قبلها الإلمام بصناعة المعادن. وصناعة المفروشات تقتضي قبلها الإحاطة بصناعة النسيج. وهما صناعتان لا تستقيمان إلا في ظل الاستقرار والتمدن، خلافا لما يزعمه اليوم أولئك المتعصبون السذج للقومية العربية.
يحتاج المغرب والمغاربة اليوم إلى استرجاع لغتهم الأم. لكن هذا لا يكفي لوحده. بل لا بد – أبعد من ذلك! – من استرجاع مكانة المغرب والمغاربة في السيرورة الحضارية لحوض البحر الأبيض المتوسط، والتي كانوا باستمرار طرفا فاعلا فيها. فنحن ـ أراد من أراد وأبى من أبى ـ لسنا جزءً من المشرق ولسنا جزءً من الخليج. بل نحن جزءٌ لا يتجزأ من الغرب وعلينا أن نسترجع المغرب الغربي وأن نعلن القطيعة مع الاستحمار المشرقي.