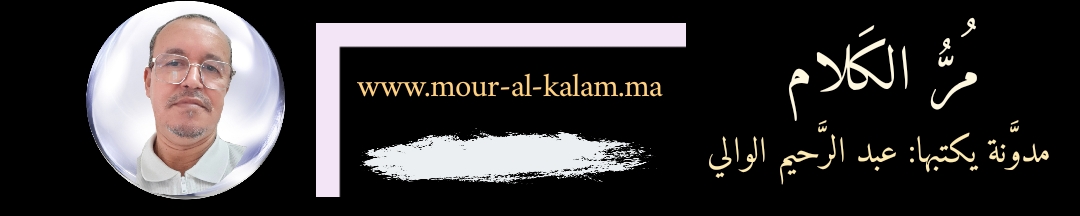حنة أرندت، كما هو معروف، هي فيلسوفة ألمانية من عائلة يهودية، أرغمها النظام النازي على مغادرة ألمانيا في سياق اضطهاده للمكونات البشرية غير الآرية، وفق أيديولوجيته العنصرية. وكما هو معروف أيضا فإن حنة أرندت التحقت بالولايات المتحدة الأمريكية، وصارت هناك أستاذة جامعية، وحصلت على وضع سَمَح لها بالكتابة وأعطاها الفرصة لتترك أثرا فلسفيا ما يزال، في تصوري، غير مطروق حتى الآن بالقدر الكافي من طرف الباحثين.
لم تكتب أرندت بالألمانية، لسانها الأم، وإنما كتبت بلسان البلد الذي استضافها وأعطاها الحضن الدافئ الذي حرمتها منه ألمانيا في ظل الهمجية النازية. ومع أن البعض يرى أن أرندت كانت تكتب بدافع الخيبة العاطفية بحكم علاقة غرامية فاشلة مع أستاذها، مارتن هايدغر، فهذا يبقى مستبعدا بالنسبة لي. ذلك أن أرندت لم تحاول مزاحمة هايدغر في مجاله الفلسفي المفضل، الذي هو الأنطولوجيا، بقدر ما اهتمت بالسياسة. وحتى إن كان لها إسهام لا يُسْتَهانُ به في مجال الأنطولوجيا المعاصرة فهي تبقى فيلسوفة السياسة بامتياز، إن لم نقل إنها أكثر فلاسفة السياسة المعاصرين دقة وعمقاً حتى وإن كانت هي تنفي عن نفسها صفة “الفيلسوفة” وتصف نفسها بأنها “دارسةٌ للسياسة”.
لا أنكر أن لشخصية أرندت جاذبية خاصة بالنسبة لي، ولا أنفي أن أسلوبها في الكتابة يسحرني، ولا أنَّ قدرتها التي لا تُضَاهى على توليد الأفكار تجعلني أقرأ وأتلذذ، ثم أعيد القراءة لأتلذذ أكثر على مَقَاس فاصل إشهاري قديم كان يقول “كلما طالت المدة زادت اللذة”. غير أن هذا ليس موضوعنا هنا. بل إن ما يستوقفني في هذا المقال بالأساس هو ما تقوله أرندت في كتابها “ما هي السياسة؟” عن أفلاطون، إذ ترى أن الرهان الأفلاطوني كان يقوم على أن تنجح الأكاديمية في تغيير المدينة. وهو الرهان الذي كان، بطبيعة الحال، خاسراً بالكامل.
وُلِدَ أفلاطون، ونشأ، وأصبح شابا يافعاً، في ظل حرب طاحنة استمرت ما يقارب نصف قرن بين التحالف الذي كانت تقوده أثينا الديموقراطية من جهة والتحالف النقيض الذي كانت تتزعمه إسبارطة الأوليغارشية من جهة أخرى. وهي الحرب المدمرة التي عصفت بأثينا، وبديموقراطيتها الفتية، وقادت إلى تجربة النظام الطغياني التي كانت مريرة رغم قِصَرِها. وبعد الحرب قرر أفلاطون أن يهاجر، ووقع في الأسر وبِيعَ في سوق النخاسة وأصبح عبدا. ولم تنقذه إلا الصدفة التي قادت إليه بعض اليونانيين الذين تعرفوا عليه ـ وهو إبن الأرستقراطية الأثينية ـ فدفعوا ثمنه لمن كان يستعبده وعادوا به إلى اليونان. وهناك اختار أن يبني مدرسته في جنائن أكاديموس، خارج أسوار أثينا، وأن يُدَرِّسَ بها الفلسفة لعلَّ الأمر ينتهي بتخليص السياسة من براثن الجهل، ولعل الفيلسوف ينجح في الوصول إلى الحكم ليمارس الواجب السياسي والأخلاقي بناء على الفضيلة بمعناها اليوناني القديم، أي بناء على الحكمة والعدل. لكنَّ الأمر انتهى إلى مأساة أكبر. فقد ظل أفلاطون غارقاً في تأملاته الفلسفية وكان ـ على عادة المدرسة المَشَّائية ـ يتأمل وهو يسير على قدميه. ولم يشعر إلا وهو يقع في بركة مائية ومات غرقاً. ومن أكاديميته تخرج أشهر تلاميذه، أرسطو، الذي صار مربياً للأمير الإسكندر إبن الملك فيليبوس، الذي سيصير الإسكندر المقدوني، صاحب الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والتي انتهت وانهارت بمجرد موت مؤسسها وهو في حوالي الرابعة والثلاثين من العمر. وفي كل ذلك لم تنجح الفلسفة في أن تغير من واقع السياسة شيئا. بل ظل الفلاسفة دائما ضحايا للسياسة من أفلاطون، إلى تلميذه أرسطو، إلى حنة أرندت، مروراً بمارتن هايدغر الذي تورط في الانتماء إلى الحزب النازي وصار ـ وهو الفيلسوف!ـ يعمل تحت إمرة عريف سابق في الجيش جعلت منه السياسة قائدا لألمانيا واصبح يتطلع إلى أن يحكم العالم بخصية واحدة.
أيُّ مآلٍ أسوأُ من أن يصبح فيلسوف في خدمة “كَابْرَانْ”!
إن الفلسفة مسؤولية. ولعل الوحيد الذي مارس مسؤولية الفيلسوف تجاه السياسي كان أيضا واحدا من تلاميذ أفلاطون، وهو ديوجين الكلبي، في تلك الواقعة الشهيرة التي يُقَالُ إنها جمعته مع الإسكندر المقدوني. ومع أن الواقعة معروفة فلا بأس من استحضارها لأن هناك، بالضرورة، مَنْ لا علم له بها. فالحكاية تقول إن ديوجين الكلبي كان يتمدد داخل برميل في إحدى ساحات أثينا القديمة، ويُعرض جسده للشمس، فإذا بالإمبراطور يقف أمامه ويسأله ما إذا كان يحتاج شيئا. لكن جواب ديوجين كان هو: “لا أحتاج منك سوى أن تتحرك من هنا لأنك تحجب عني الشمس!”
لم تكن الشمس التي قصدها ديوجين الكلبي هي الشمس الحسية. بل إن الشمس في النسق الأفلاطوني (وديوجين خريج أكاديمية أفلاطون) ترمز إلى الحقيقة. إن أول ما تبدأ به جمهورية أفلاطون هو الاحتفال بعيد الإلهة بِنْدِيس، إلهة الشمس، وآخر ما ينتهي إليه السجين الذي يغادر الكهف، في الكتاب السابع من “الجمهورية”، هو الشمس. وفقط حين تشرق الشمس، في حديقة بيت سقراط، يدرك أبقراط حقيقة مسعاه إلى التعلم من بروتاجوراس. فكأن عبارة ديوجين الكلبي كانت تريد أن تقول إن السياسي/الإمبراطور يحول بين الفيلسوف والحقيقة.
نعم، لقد مات ديوجين بالطبع ولم يقتله الإسكندر جَرَّاء ردِّه الجريء. بل إنه قام بالتوقف عن التنفس بملء إرادته كما تقول الحكاية، أي أنه حَبَسَ أنفاسَه حتى الموت وكأنه، حتى في موته، كان يقول بأن هواء المدينة/الدولة التي يحكمها سياسيون ليسوا فلاسفةً هو هواء لا يستحق أن يتنفسه الفلاسفة. ولعل ذلك كان إعلانا عن فشل رهان تغيير المدينة عبر الأكاديمية ساقَه ديوجين بطريقته قبل أن تعلنه حنة أرندت مرة أخرى في القرن العشرين.
إن هواء السياسة فاسد بالضرورة ولا يصلح لرئتي الفيلسوف!