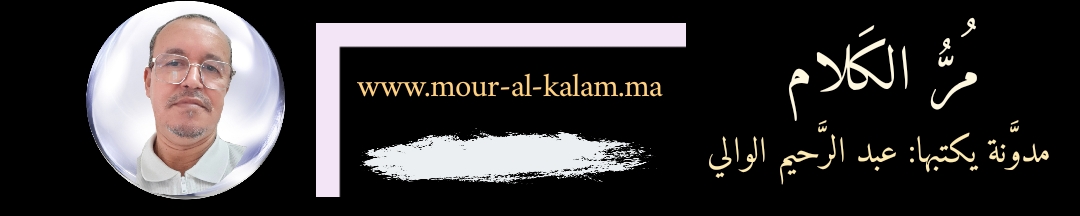الفلسفة مُتعة. وهي لذة اللذات، وقمة السعادة، في المنظور اليوناني القديم، أي في السياق الثقافي والسياسي والاجتماعي الذي فيه ظهرت، وتطورت، وانتظمت. وهي كذلك على الأخص في دولة أثينا القديمة، حيث تجاور تطوُّرُ وانتظامُ الفلسفة مع النشأة الأولى للديموقراطية. ولذلك قصة تستحق أن تُذكَر على سبيل الاختصار الشديد.
كان نظام الحكم في أثينا نظام أقلية، إذ كانت جماعة ضيقة، أوليغارشية، هي التي تختار حاكم المدينة. ولم يكن لعامة الشعب الأثيني حقُّ الاختيار السياسي. وفي الآن نفسه كانت قوانين أثينا تقضي على كل مَدينٍ عَجَزَ عن تسديد دينه بالحذف من سجلات المواطَنَة، أي أنه كان يفقد صفته كمواطن. وعلاوة على ذلك فقد كان يتحول إلى عبد لدى الدائن لمدة تُعادل ما عليه من دَيْن. وقد حدث أن وَجَدَ عدد كبير من المواطنين الأثينيين أنفسهم في هذا الوضع، أي أنهم عجَزُوا عن تسديد ديونهم، فصاروا عبيدا لدى دائنيهم، وفقدوا وضعهم السياسي كمواطنين. وبما أنهم قد صاروا عبيدا فهم لم يعودوا مُلْزَمين بأداء الضرائب للدولة ولا بالدفاع عن أثينا في حالة الحرب، أي أن أثينا الأوليغارشية صارت دولة بدون جيش وبدون أموال.
هذه الأزمة هي التي تُعرف في التاريخ اليوناني القديم ب”أزمة الديون”. وقد تصادفت مع وصول واحد من الحكماء السبعة إلى كرسي الحكم في أثينا، وهو الشاعر الحكيم سولون. فكان أن أعلن سولون عن إلغاء الديون، وإعادة تسجيل المواطنين المَدينين في سجلات المُواطنة، إضافة إلى إعادة توزيع الأراضي الزراعية، مع السماح لكل مواطن يملك قطعة أرض ويحقق من خلالها محصولا سنويا بأن يصوت على مَن يحكم أثينا، وبأن يُرشح نفسه ليصير هو نفسُه حاكماً لأثينا. وكانت إصلاحات سولون الحكيم هذه هي بداية النظام الديموقراطي، لأول مرة، في التاريخ البشري.
ظُهُور الديموقراطية كان له انعكاس مباشر على حياة الأثينيين القدماء. فقد صار مجال التباري السياسي هو الساحة العامة. وغدت وسيلة التباري هي الإقناع والاستمالة. فتطورت البلاغة، وبرز الخطباء المَهَرَة، وصارت جمالية اللغة بالأساس هي الأداة الحاسمة في استمالة الجمهور سياسياً. بَيْدَ أن هذا “الجَمَال” قد يكون حقيقيا كما قد لا يكون، أي أنه قد يكون زائفاً. ومن تمَّ صار لزاماً أن يتسلح المرء بمعيار للتمييز بين الحقيقة والزَّيف، فبرز سؤال الحقيقة في ذلك الزمن الأثيني المأساوي، الموسوم بالحرب والطاعون، باعتباره السؤال الذي شّكَّلَ صُلب المايوطيقا الأفلاطونية كما جسدتها شخصية سقراط في المحاورات. وهي الشخصية التي كانت تمارس مهمة “الوخز” بواسطة الأسئلة المتسلسلة، اللامتناهية، التي لا تكاد تستثني شيئا، وتدفع المواطن إلى فحص كل شيء ابتداء من نفسه وانتهاء بالدولة. وبفعل ذلك الوخز كان أفلاطون يلقب شخصية سقراط ب”ذبابة أثينا” لأنه في نظره كان يقوم بدور شبيه بذاك الذي تقوم به “ذبابة الخيول”.
وهو يقوم بدوره ذاك، كان سقراط، كما ترسمه المحاورات الأفلاطونية، يجوب أثينا حافي القدمين. وذلك، بالطبع، لم يكن بسبب الفقر وإنما كان اختيارا واعيا: الفلسفة التصاق بالأرض. وبُعْدُها كسعادة قصوى يكمن في ذلك بالضبط. فهي، عبر التصاقها بالأرض، لا تنفصل عن واقع الدولة، ولا عن هموم المواطن، ولا تتغافل عن خطر وقوعهما معاً ضحية الزيف والخُطباء الذين يبيعون الأوهام باسم “الديموقراطية”. إن الديموقراطية لم تبدأ مع سولون الحكيم بالتصويت. بل إنها بدأت ـ وليتَذَكَّر ذلك مَن يهمه الأمرُ جيداً ـ بتحرير المواطن من الدَّيْن الذي يحوله إلى عبد، وتمكينه من قطعة أرض يحقق منها محصولا سنويا. فكأن سولون كان يقول بإصلاحاته تلك إن المُواطنة ليست مجرد سِجِلٍّ انتخابي، وأن المواطنين ليسوا فولكلوراً انتخابياً، وأن المواطن لا يكون مواطنا إلا متى كان حُراُّ على قطعة أرض يملكُها حُرَّةً خالصة له وهو فيها غَيْرُ مَدين. أما وهو يعيش في بلد لا يملك فيه موطئ قدم، أو يُفني فيه عمره ليسدد قرضا يحصل في نهايته على شقة لا يستطيع أن يعطس فيها دون أن يُشَمِّتَه جارُه، فهو قد يكون في أحسن الأحوال مواطنا بالقوة لا بالفعل.
وكأن أفلاطون وهو يضع أسس الفلسفة النظامية قد التقط الإشارة من سولون كما يجب فأخذ اللفظ الدال على قطعة الأرض، بالضبط، والذي هو لفظ “Ousia”، وأخرجه من دلالته المباشرة تلك ثم جَعَلَه دالا على معنى “الماهية” (Essence)، أي على معنى الحقيقة الثابتة للأشياء. وذلك علماً أن سؤال الماهية، أي سؤال الحقيقة، هو الذي شَكَّل جوهر المايوطيقا الأفلاطونية كما تجسدت عبر شخصية سقراط وفق ما سبق أن أشرنا إليه سواء في هذا المقال نفسِه أو في مناسبات سابقة.
إن الحقيقة الأفلاطونية بهذا المعنى ليست في سماء الميتافيزيقا وإنما هي راسخة في أرض السياسة. وهي ليست على ما يبدو في مدارات المُثُل أو المعقولات المُفارقة، بل هي حيث نحن بالضبط. إنها تتجلى في مواطن حر، ليس مديناً لأحد، يضع قدميه ويقف شامخا بملء قامته على قطعة أرض في ملكيته. ثم بعد ذلك يكون له حق التصويت. ولا معنى لحق التصويت لكل مَنْ لا أرض له لأنه، بكل بساطة، لا ماهية له، أي لا حقيقة له كمواطن. وهنا لا توجد ديموقراطية وإنما يوجد وهم الديموقراطية. بل إنه “الطَّنْز”! وفي كل المجتمعات التي تتحول فيها السياسة إلى “طَنْز” تتحول الفلسفة من متعة وسعادة إلى محنة. والأدهى أنها قد يمتهنها بعض الذين يعتنون بأردافهم أكثر من أدمغتهم.