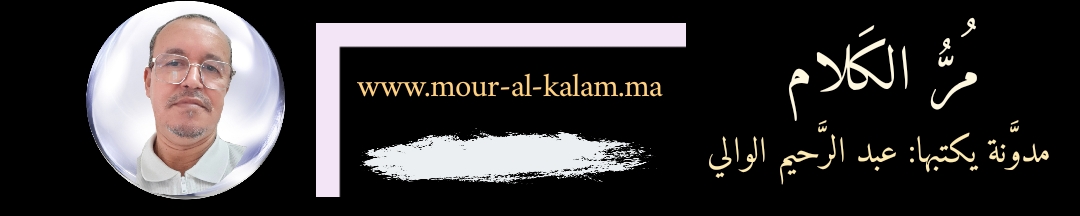ثمة فكرتان تبدوان متلازمتين في الخطاب السياسي الحالي داخل المنطقة الناطقة بالعربية، والممتدة من المغرب إلى اليمن، رغم أنهما فكرتان ظهرتا في زمانين ومكانين مختلفين. وأعني هنا فكرة الديموقراطية وفكرة الحداثة. وإذ نتحدث بالتحديد عن المنطقة الناطقة بالعربية فهذا لا يرجع إلى أي اعتبار “قومي”، وإنما هو يعود إلى كون فكرة الحداثة لم يعد لها طابع الراهنية في الغرب الذي يتحدث منذ زمن عن “ما بعد الحداثة”.
الديموقراطية، كما يعرف ذلك كل من سبق له أن درس تاريخها، هي فكرة قديمة، نشأت في اليونان القديم، وتحديدا في أثينا القديمة. أما الحداثة فهي قد بدأت تاريخيا في أواسط القرن الخامس عشر، مع سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين على عهد السلطان محمد الفاتح، وفلسفياً مع إعلان ديكارت عن ميلاد الذات من خلال الكوجيتو: “أنا أفكر إذن أنا موجود”.
وفي هذا المقال لا تهمنا الديموقراطية القديمة ولا الحداثة بمعناها التاريخي. بل تهمنا الديموقراطية المعاصرة والحداثة بمعناها الفلسفي.
فالديموقراطية القديمة قامت على فكرة المُوَاطَنَة. ذلك أن اليونان القديم كان يقيم تمييزا واضحا بين المواطن وغير المواطن. ولا ديموقراطية إلا للأول الذي له حق الكلام في المجال العام. أما الثاني، أي غير المواطن، فلم يكن له نفس الحق، أو أنه كان ـ كما تقف عند ذلك حنة أرندت ـ “Aneu logon”، أي مجردا من حق الكلام في الحياة العامة، ولا ديموقراطية له بالتّبعة. وهذا كان شأن العبيد، والنساء، والأطفال. فهؤلاء جميعا لم يكونوا قادرين على التفكير مثل المواطن، أي مثل الذكر البالغ الحر، لأن العبد “آلة حية” حسب أرسطو، والمرأة “ناقصة عقل” حسب نفس الفيلسوف، وهي حسب استاذه أفلاطون من طبيعة بشرية أدنى من طبيعة الرجل، وكذلك الأمر بالنسبة للطفل الذي يعتبر مجرد شيء في ملكية الأب.
وعليه، فهؤلاء جميعاً ليست لهم أي حقوق سياسية على الإطلاق لأن الحق مرتبط بكيانية سياسية هي المواطن، أي الذكر البالغ، الحر، القادر على التفكير، والذي له وحده حق الكلام العمومي.
هذا التمييز هو الذي تلقفته الأزمنة الموالية ورددته بصيغ عديدة، متنوعة، ومختلفة. فكان التفكير، وحق الكلام العمومي، وحق المشاركة في صياغة القرار السياسي ـ في أحسن الأحوال ـ حكراً على المواطن بالمعنى الذي تقدم. أما في أسوأ الأحوال فقد كان ذلك وّقْفاً على زُمرة قليلة من أصحاب المال والسلطة ورجال الدين. ونحن نتحدث هنا، بالطبع، عن الغرب حيث ظهرت فكرة المُواطَنَة منذ القديم. أما في العالم الإسلامي ففكرة المواطنة لا وجود لها في العصر القديم، ولا في العصر الوسيط، ولا حتى في الأزمنة الحديثة. وهي لم تدخل القاموس السياسي العربي الإسلامي إلا تحت تأثير الاستعمار، ومع احتكاك النخبة بأفكار النهضة، وبعدها بأفكار عصر التنوير، حيث ابتُدعت كلمة “المُواطن” في اللسان العربي. أما قبل ذلك فالفارابي وهو يكتب “آراء أهل المدينة الفاضلة”، ويستلهم من خلاله جمهورية أفلاطون، لم يجد مرادفا لكلمة “Politès” اليونانية، ولم يَهْتَدِ مع الأسف إلى نحت كلمة “المُواطن”، فاصطنع عبارة “أهل المدينة” كترجمة تقريبية للكلمة اليونانية. وهذا موضوع قد نعود إليه ببعض التفصيل في وقت لاحق.
وحده القادر على التفكير كان له حق الكلام العمومي، أي حق المشاركة السياسية. ودائرة “القادرين على التفكير” كانت تتسع أو تضيق حسب معطيات كل عصر. لكنها لم تتسع قّطُّ لتشمل الجميع إلا في القرن السابع عشر، عندما حطم رجلٌ اسمُه ديكارت خرافات الأزمنة الغابرة، وأثبت بالاستدلال العقلي أن جميع الناس لديهم مبدئيا نفس القدرات العقلية، وأن كل إنسان قادر على التفكير، أي أنه قادر على أن يشك، ويريد، ويثبت، وينفي، ويحس، ويتخيل…إلخ.
ومع اللحظة الديكارتية بَرَزَ هذا الكيان الجديد، القادر على التفكير دون اعتبار لوضعه الاجتماعي أو السياسي، أو جنسه، أو عرقه، أو لونه، أو غير ذلك. وذلك الكيان هو “الذات” (Le sujet). ومنذ هذه اللحظة ستغدو الحقوق مرتبطة بهذا الكيان الذي سيتطور مفاهيمياً عبر اللحظات الفلسفية الكبرى في العصور المواالية ليُفرز مفهوم الفرد ـ كما يقف عند ذلك ماركس ـ خلال القرن الثامن عشر، وليعطي مفهوم “الشخص الإنساني” ككيان مقدس مع إميل دوركايم.
هكذا، فجوهر الديموقراطية المعاصرة ليس المؤسسات المنتخبة، ولا القوانين التي يتم إقرارها بالتصويت، ولا الدساتير التي يجري تبنيها بواسطة الاستفتاء العام. بل إن روح الديموقراطية المعاصرة هي عينُها جوهر الحداثة، أي فكرة الذات من حيث هي كيان مستقل قادر على التفكير، ويثبُتُ وجودُه من خلال تفكيره نفسِه، وله بحكم ذلك مطلق الحرية في أن يفكر كما يشاء، وأن يتصرف وفق تفكيره الحر. وهذا ما لا تسمح به إلا الديموقراطية المعاصرة. وهو أول ما تغتالُه الأنظمة الاستبدادية، والكليانية، والدكتاتورية، والتنظيمات المتكلسة، وتلك القائمة على الخضوع المطلق ل “الشيخ” أو “الزعيم”. إنها جميعُها تغتال الذات، أو لنقل بقاموس عصر الأنوار إنها تغتال الفرد، أو أنها تغتال “الشيء المقدس بامتياز”، أي أنها تعتال الشخص الإنساني، إذا ما جاز لنا أن نستعير العبارة من دوركايم مرة أخرى.
على هذا الأساس فإن الدفاع عن الديموقراطية، وطنياً وكونياً، ضد الاستبداد والدكتاتورية والكليانية، وضد جميع التنظيمات ذات الطابع الاستلابي، يُعتبر دفاعاً عن الذات، لا بل دفاعاً عن حق الذات في الحياة كذات، أي عن حقها في التفكير الحر، وفي الكلام العمومي، وفي المشاركة في صنع وصياغة القرار السياسي. وكل مَنْ يدعو اليوم إلى أي شكل من أشكال التمييز في حق المرأة، أو في حق بعض الأقليات، أو يريد فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال على الفرد في حياته الخاصة، فهو يمثل تهديدا مباشرا للذات، أي لجوهر الديموقراطية المعاصرة، وتعتبر مواجهتُه تجسيدا للحق في الدفاع الشرعي سواء بالنسبة للذات ككيان، أو بالنسبة للديموقراطية المعاصرة كنظام.
ولا عزاء لعبيد الخرافة!