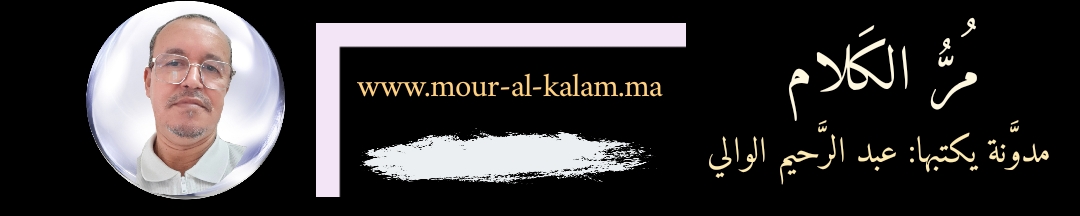في المغرب الحالي، لا يمكن أن يدافع عن نزاهة القيادات النقابية، ولا عن مصداقيتها، إلا مُخَدَّر، أو مُغَفَّل، أو بليد. أما باقي المغاربة فهم يعرفون، منذ زمن بعيد، أن أباطرة النقابات لا علاقة لهم بقضايا العمال، ولا بقضايا المأجورين عموما، وأنهم فئة مستفيدة، مثل فئات أخرى، من الامتيازات التي يتيحها لهم موقعهم على رأس الهيئات النقابية. ولذلك فهم ـ مثل قيادات الأحزاب أيضا ـ يتشبثون بمواقعهم تلك ولا يغادرونها إلا مطرودين من طرف مافيات أقوى منهم، أو محمولين داخل النعوش.
وما دام الأمر على هذا النحو، فسيكون من العبث أن نتحدث اليوم عن هذه القيادات لأن كل ما يمكن أن نقوله عنها لن يكون، في آخر المطاف، إلا بمثابة تحصيل حاصل. لكن هناك، بالمقابل، فئة تستحق أن نقف عندها من باب التنبيه إلى الخطر الذي تمثله. وهي الفئة التي نسميها هنا ب “النقَّابَة”.
هؤلاء، أي “النقَّابة”، ليسوا سوى مأجورين بدورهم سواء في القطاع العام أو الخاص. وأول ما يميزهم هو الاستعداد التام، والدائم، لفعل كل ما يرضي “الزعيم” النقابي وحاشيته. فهم يتسابقون لأداء أعمال السخرة للزعيم والحاشية، ويقبِّلُون الرؤوس والأيادي، وينحنون إلى الحد الذي تصبح فيه مؤخراتهم فوق رؤوسهم. وهذا ليس دون مقابل بالطبع. فهم يستفيدون مما يمكن أن نسميه فُتات الريع النقابي لأن “الريع الكبير” تستفيد منه القيادات نفسُها. وأول مظاهر هذا الريع هو ما يسمى ب “التفرغ النقابي” الذي طالما اغتنى عن طريقه النقَّابة. وقد عايشت عن قرب حالة أحدهم الذي بدأ حياته مدرسا للعلوم الطبيعية بالسلك الإعدادي في النظام القديم، ثم صار “مُوجِّهاً” قبل أن يحصل على التفرغ النقابي، ويستفيد من سكن وظيفي لا حقَّ له فيه أصلاً، ويتحول إلى “صحافي” أيضا، قبل أن يتبين في آخر المطاف أنه كان “فلاَّحاً” في نفس الوقت.
بالتأكيد، فليست حالة هذا “الرفيق” هي الوحيدة، مثلما أن التفرغ النقابي ليس المظهر الوحيد لفُتات الريع الذي يلعقُه النقَّابة عند أقدام أسيادهم. والنقَّابة ليسوا ذكورا دائما. فهناك أيضا “نقَّابات”، بمؤخرات مستديرة يصل قطرُها أحيانا إلى ثمانين سنتيمترا، وصدور طازجة، ناضجة، مائجة، يتولين تنظيم “الجلسات” لفائدة أصحاب القرار النقابي. وهن أيضا يستفدن من مختلف أشكال وأنماط الفُتات الريعي، بل وقد صرن يُدِرْنَ في كثير من الحالات مافيات وكارتيلات محلية لقضاء المآرب المختلفة باسم “المكتب النقابي” داخل الجماعة، أو المقاطعة، أو الجهة، أو الإقليم.
هذا الوضع، الذي تفوح رائحتُه منذ عقود من داخل النقابات، جعل الأغلبية الساحقة من المأجورين تتأفف من العمل النقابي وتتعفَّف عن السقوط في نفس المستنقع. وبين التأفُّف والتعفُّف يفضل البعض التعبير عن مطالبه ومظالمه من خلال تنسيقيات، أو بشكل فردي عبر وسائل التواصل الاجتماعية، أو حتى أن البعض (مثل حالتي) يكفُر بالنقابات والتنسيقيات على الجملة وبالتقسيط أيضا. والنتيجة هي أن الحياة المهنية، في شقها النقابي المفترض، تصبح خارج أي آلية تأطيرية بكل ما لذلك من انعكاسات خطيرة. أضف إلى ذلك أن أموال الدعم العمومي المخصص للنقابات في هذه الحالة تُصرَفُ عبثاً على هيئات مُحنَّطَة لا تخدم سوى قياداتها المُتكلِّسَة، وخُدَّامَها من النقَّابَة، وخادماتها من متعهِّدَات الحفلات الخاصة، صاحبات الصدور النَّافِرَة، والمؤخرات الظَّافِرَة، الراسخات في فنون “امتصاص الغضب” وتلطيف الأجواء بما تيسَّر من علم “اللسانيات السريرية”. والأدهى والأمَرُّ أن هذا العلم العجيب، أي علم اللسانيات السريرية، ينجح في كثير من الحالات في توليف الأضداد فيجمع بين البروليتاريا والباطرونا، وبين الإدارة والشغيلة، وما لا يمكن تصورُه من عفاريت الإنس الذين ما كان سليمانُ نفسُه ليقوى على جمعهم في عز مُلْكه. وإذ يجتمع هؤلاء فهم لا يأتلفون إلا ضد الموظف أو المستخدم المُخلص، المتفاني في عمله، والحريص على نظافة يده قبل قلبه.
فنحن، في الواقع، لم نعد أمام تنظيمات نقابية لأن النقابات توفيت إلى رحمة الله منذ زمن. وهي كما قال “صاحب الخُزَامَى” لم تعد سوى “جثامين لم تُدفَن بعد”. بل لقد أصبحنا أمام تنظيمات مافيوزية في جميع القطاعات تتواطأ، وتتآمر، وتصنع الدسائس والدسائس فقط!