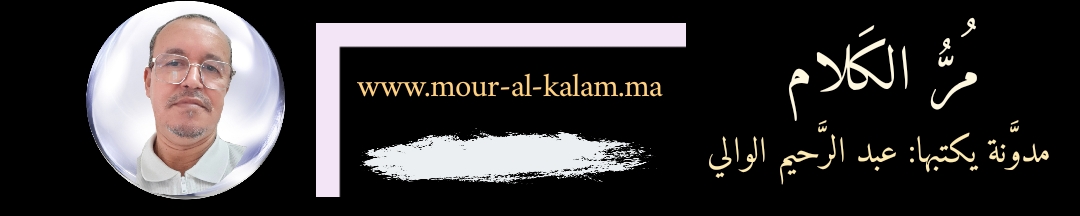فريدريك نيتشه، ذاك الذي لم يعرف حتى كيف يموت حسب “الشيخ” هاشم البسطاوي، له كتابٌ شهير عنوانُه “العلم المَرِح”. وهو ـ مثل العديد من كتابات نيتشه الأخرى ـ ليس كتاباً ذا موضوع واحد وإنما هو قد كُتِبَ بطريقة شَذَرية، وتعالج كل فقرة من فقراته موضوعاً يكاد يكون منفصلا بالكامل عن المواضيع التي تتصدى لها باقي الشذرات. وفي إحدى هذه الشذرات يعالج نيتشه أصل الوعي.
وقبل أن نتطرق إلى ما يذهب إليه نيتشه في هذا المنحى لا بد أن نسعى إلى تبسيط القضية بالنسبة للقارئ غير المختص. وأُولى خطوات التبسيط أن نشرح المقصود ب”الوعي”. والمقصود، بالطبع، هو تلك المَلَكَة الموجودة لدى الإنسان، والتي بواسطتها يستطيع أن يعرف نفسَه أولاً وأن يعرف العالم الخارجي ثانياً. وهي مَلَكَةٌ تجعلُه متميزا عن باقي الأنواع الحيوانية بكل تأكيد.
لكن الإنسان، مع ذلك، لم يأت من خارج مملكة الحيوان وإنما هو أيضا واحد من الأنواع الحيوانية. وقد مرَّت عليه مراحل من التطور لم يكن فيها واعياً. بل إن الفرد من النوع الإنساني، إلى اليوم، يأتي إلى العالم مُجرَّداً من مَلَكَة الوعي. فالمولودُ الجديد يأتي بدون وعي، ثم يكتسب وعيَه بالتدريج مع تقدمه في مراحل النمو. وكذلك النوع البشري بأكمله. فقد كان في طفولته نوعاً غيرَ واعٍ وصار واعياً. والسؤال هو: كيف صار كذلك؟
يجيب نيتشه عن هذا السؤال بأن الوعي تشكل لدى الإنسان لكونه أولاً كائناً هشاًّ، يحتاج دائما للرعاية من غيره، بخلاف أغلب الحيوانات الأخرى. وبحكم هشاشته وحاجته للرعاية فقد كان يحتاج إلى التعبير عن ألمه، ونقل معاناته لغيره، فكان ذلك سبباً في ظهور وتطور اللغة. أضف إلى ذلك أن الجماعات البشرية المختلفة، حين تشكلت، كانت في حاجة إلى تنظيم اجتماعها، وإلى إفراز زعماء يقودونها. وقد كان هؤلاء القادة في حاجة إلى توجيه الأوامر لأفراد بعينهم. وكان من الضروري أولاً تمييز الآمر عن المأمور، ثم صار من الضروري أيضا التمييز بين المأمورين أنفُسِهم حتى يعرف كل واحد ما إذا كان الأمر موجهاُ له أم لغيره. ومن هنا كان تطور اللغة وتطور الوعي لدى الإنسان بالتوازي. ف”تطور الوعي وتطور اللغة يسيران يداً في يد” كما يقول نيتشه.
لا تهمنا هنا جميعُ تفاصيل وجوانب مشكلة الوعي كما يقاربُها فريدريك نيتشه. وإنما يهمنا من كل ذلك، بالدرجة الأولى، جانبٌ واحدٌ وهو أن الوعي قد تَشَكَّل في علاقة القائد بالتابع، أي في علاقة الآمر بالمأمور، وفي علاقة الزعيم بالقطيع. وعليه، فمهما كان الوعيُ كلمةً مُحَمَّلَةً بدلالات “التحرُّر” و”الانعتاق” و”الاستقلالية” فإنه يبقى حالةً قطيعية واستلابية بامتياز. فهو لا يتشكل كَمَلَكَة لدى الفرد إلا عبر المغايرة، أي من خلال علاقته مع غيره. وهو أيضا لا يتشكل إلا من خلال اللغة وعبرها. واللغة لا تتشكل بدورها ولا تُكتسَب إلا عبر الغير ومن خلاله. والوعي أيضا، بحكم انتماء الفرد بالضرورة إلى جماعة بشرية ما، وبحكم وجود قائد لهذه الجماعة بالضرورة أيضا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون طريقاً لتحرُّر الفرد. فحيثما كان هناك وعيٌ كانت هناك لغة. وحيثما كانت هناك لغة كانت هناك جماعة. وحيثما كانت هناك جماعة كانت هناك قيادة وكان هناك تابعون، وكان آمرٌ ومأمورٌ، أي كان هناك مُسْتَلِبٌ ومُسْتلَب. ولا ينفلت من هذا إلا المجنون، أو الميت، أو الحيوان الذي لم يكتسب بعدُ أي درجة من درجات الوعي، أو الذي ليست لديه بالمرة قابليةُ الاجتماع. بمعنى آخر، فإننا جميعاً مُسْتَلَبُون بدرجاتٍ متفاوتة. ولو شئنا التعبير عن ذلك بالقاموس التشاؤمي المستوحى من شوبنهاور ـ وهو بالمناسبة مُلْهِمُ نيتشه ـ لقُلنا بأنه لا تحرُّرَ على الإطلاق في ظل الوعي واللغة وإنما أفُقُنَا الأقصى هو استلابٌ أقلُّ.
أفقُ الاستلاب الأقل هذا هو الذي يسعى إلى تحقيقه أولئك الأفراد الذين يختارون التفكير بطرق مختلفة. وهؤلاء هم الذين يصيرون في الغالب مبدعين، أوفلاسفة، أوغير ذلك، ويُنعَتُون ب”العبقرية” في حالاة نادرة، بينما يُوسَمُون عادةً ب”الشذوذ” و”المُروق” أو حتى أنهم يُنعتون من طرف السلطات الدينية ب”الهرطقة” و”الزندقة”.
فالناس لديهم، بحكم كون الوعي حالةً قطيعية كما تقدم القول، ميلٌ إلى تصديق الكثرة، أي الأغلبية، حتى وإن كانت أحكامُها خاطئة تماما. ذلك أن الغاية الجماعية من تأسيس الوعي، في القطيع البدائي الأول، لم تكن تحرير الفرد وإنما كانت هي المحافظة على كيان الجماعة وضمانُ استمرارها واستقرارها. وهي، أي الجماعة، تكون أكثر قدرة على الاستمرار والاستقرار إذا كانت متفقة ومتواطئة على نظام من المواضعات التي تبدأ باللغة وتنتهي بالسياسة. ولذلك فهي تنبذ كل فكرة فردية تختلف معها مهما كانت ذكية، وتُمَجِّدُ كل ما تلتف حوله الكثرة مهما كان غارقاً في الغباء. و”غباءُ الكثرة” هذا هو الذي يجد التعبير الأوضحَ عنهُ في أمثال “الشيخ” هاشم البسطاوي، ونظيره المدعو إلياس العمري، وجماعة “النهج والإحسان”، وأتباع بنكيران، وكلِّ مَنْ سارَ على نهج هؤلاء وأولئك عبر تاريخ الإنسان. وإلا فليشرح لنا مَن يخالفُنا القول كيف يمكن لعاقل أن يصرح بأن عددا من الفلاسفة قد ندموا بعد موتهم. فحتى الآن لم يعد أحدٌ من الآخرة ليحكي لنا عن أحوال الموتى هناك، ولا توجد أي وسيلة إعلام تبث الأخبار من جهنم.